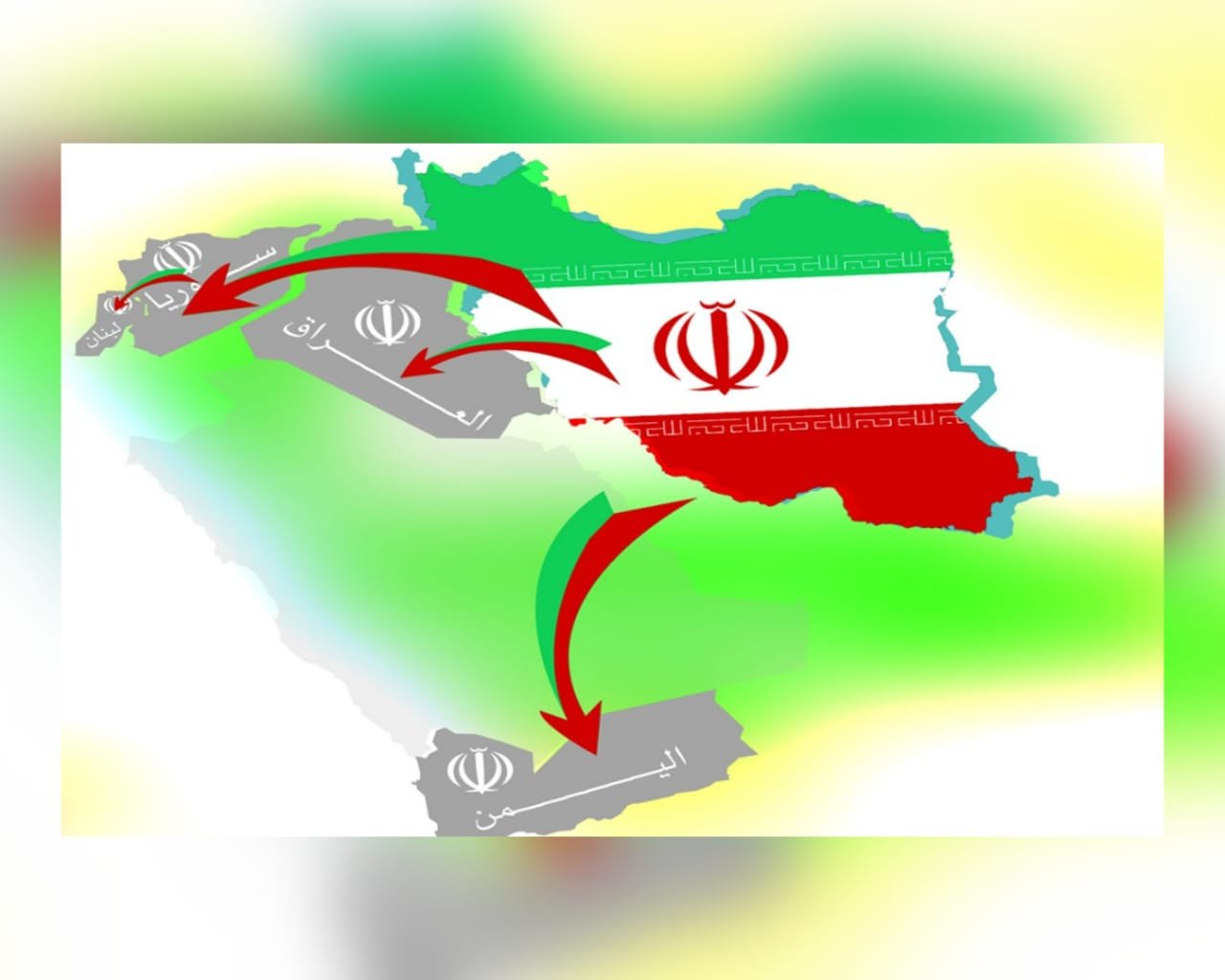انقضت أكثر من ثلاثة عقود، وما يزال الاستراتيجيون الأميركيون على وجه الخصوص مذهولين بظواهر عودة الدين. ولأنّ كثيرين منهم ذوو أصول يسارية أو ليبرالية، فقد ارتبطت تلك العودة في تحليلاتهم بصعود اليمين المحافظ أو الرجعي، الذي أدرك أهمية الدين في اجتذاب الجمهور المتديّن نحو صناديق الاقتراع، في مقابل إعطائه وعوداً بأمورٍ ومطالب في السياسات الداخلية، والأُخرى العالمية.
إنّما من أين ظهر هذا الجمهور المتديّن المهتم بالشأن السياسي بعدما كان الظنّ أنّه ليس موجوداً؟!
الدين العامّ في الولايات المتحدة ظاهرةٌ سائدة، لكنّ الجديد ظهور الاهتمام لدى الجماعات الإنجيلية الجديدة بالتأثير في الشأن العامّ، والسعي لإحقاق مطالب محدّدة. رونالد ريغان في مطلع الثمانينات كان الأبرز في الإفادة من هذا الأمر. فقد كان ثلاثون بالمائة من ناخبيه من الإنجيليين الجدد. لكنّ المشكلة في هذا التفسير أنّ ريغان هزم جيمي كارتر الذي كان إنجيلياً حقيقياً بخلاف ريغان الذي كان نجماً سينمائياً، وكان تديّنه تمثيلاً أيضاً. فلماذا احتذب الممثل هؤلاء الإنجيليين ولم يجتذبهم المتدين الإنجيلي الأصيل؟ ثم إنّه ولخمسة عشر عاماً حصل على الرئاسة آخرون لا يُعرف عنهم تديُّنٌ لا حقيقةً ولا تمثيلاً. ثم أطلَّ جورج بوش الابن، وتعاظمت من حوله الدعاية أنّه من التائبين ومن صنف الإنجيليين “المولودين ثانيةً” بحسب ما يقال. إنّما مرةً اُخرى جاء بعده وعلى أنقاضه أوباما الملوَّن الذي لم يستخدم في نجاحه الدين على الإطلاق.
سكوت هيبارد في كتابه “السياسات الدينية والدول العلمانية” (2010)، ومستخدماً نماذج لاستغلال الدين في السياسة من الولايات المتحدة والهند ومصر، يصرّ على أنّ أنظمة الحكم في تلك البلدان مسؤولة إلى حدٍ كبير عما صار يُعرفُ بـ”الصحوات” وبـ”الدين السياسي. “في حين يُصرُّ بوتنام، ومستنداً إلى إحصائيات (بين 2007 و2019) على أنّ استغلال الدين في السياسة بضاعةٌ خاسرة، وليس في أميركا فقط، بل وفي أوروبا والعالم أيضاً. وأدلته على ذلك في أميركا بالذات الإعْراض المتزايد من جانب الشبان (وبعضهم متديّن) عن الحزب الجمهوري بسبب استعماله الدين. بل وأكثر من ذلك فإنّ كثيرين في أميركا ومن شتّى الفئات العمرية يتركون الذهاب إلى الكنائس، وذلك قرفاً من التسييس الكثيف الذي دمَّر حتّى العِظات في الكنائس. فالكهل الأميركي لا يأتي إلى الكنيسة ليسمع عظاتٍ في معارضة الإجهاض والمثليين والانتصار لهذا السياسي المتدين أو ذاك. ومن بين زهاء الخمسين دولة جرت فيها استطلاعات، نصفها دول إسلامية، تحتفظ الأكثريات بتديّنها، باستثناء إيران الإسلامية التي انخفضت فيها نِسَب التدين (وليس الإيمان) بين الشباب، بسبب الإسراف في استخدام الدين والمذهب من جانب النظام الحاكم.
الدين العامّ في الولايات المتحدة ظاهرةٌ سائدة، لكنّ الجديد ظهور الاهتمام لدى الجماعات الإنجيلية الجديدة بالتأثير في الشأن العامّ، والسعي لإحقاق مطالب محدّدة
فرانسيس فوكوياما المشهور، في كتابه: “الهوية وسياسات الكرامة والغضب” (2016)، وبرتران بادي، في كتابه “الشعبويات” (2018) يبدآن من مكانٍ آخر. الدين عاملٌ معتبرٌ في صناعة الهوية والخصوصية، لكنّه ليس الأهمّ. فمنذ السبعينات من القرن الماضي بعد ثورات الشباب عام 1968، تغيرت الذهنيات والثقافة السياسية في الغرب على وجه العموم. وحلّت بالتدريج ثقافة الحقوق محلَّ ثقافة الواجبات. ثقافة الواجب هي ثقافة قيمةٍ (أخلاقية)، وهي ثقافةٌ مسيحيةٌ بروتستانتية إلى حدٍّ ما. وهذا شأن الطبقات الوسطى صانعة قيم المجتمعات وذهنياتها. أما ثقافة الحقوق فهي ثقافة حقٍ في المساواة والمشاركة. ولذلك صعدت الفئات الاحتجاجية التي تريد المشاركة في قيم الطبقات الوسطى وأوضاعها المتميزة. وبين القيمة والحقّ، وسط ظروف الاحتقان العالمي بسبب تفكك الاتحاد السوفياتي وزواله، تحطّم التوازن المستقر لصالح ذهنية القيمة والكفاءة والنشاط الفردي. وساد المجتمعات في الغرب وفي العالم كلّه اضطرابٌ، استنصر خلاله أهل الحقوق، المستندون إلى إحساساتٍ عميقةٍ بالكرامة المهدورة لأسبابٍ دينيةٍ أو إثنيةٍ أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، بالاحتجاج والتذمر الدائم الذي أبرز هذه العوامل كلّها دفعةً واحدة.
وقد تبيّن أنّ إحساسات الانظلام والتهميش لا تقتصر على الملوّنين والمهاجرين والأقليات، بل تدخل فيها فئات بيضاء على حواشي المدن أُخرجت من مجرى سيل العولمة المندفعة. وفي حين عجزت الأحزاب التقليدية عن استيعاب المتغيّرات العاصفة وظلّت قابعة تحت شعارات المساواة والعدالة والحرية منذ الحرب الثانية، ظهرت زعاماتٌ وقياداتٌ جديدة، وفيما وراء وما فوق الأحزاب و اليمين واليسار، لتلتقط الأنفاس القلقة لهذه الفئة المتذمرة أو تلك من فئات الجمهور الجديد المتلاطم. وهكذا برزت أربع قوى أو عوامل: الزعامات الكارزماتية التي تعطي فئاتٍ من الجمهور الأمل بالقدرة على تحقيق كلّ المطالب المعقولة وغير المعقولة – وقوّة الإعلام ووسائل الاتصال البالغة الفعالية والتأثير – وقوة الحشد The Crowd بحسب تعبير الياس كانيتي، وأخيراً قوّة أو أحاسيس الخوف على المصائر من جانب الطبقات الوسطى المميَّزة والمحسودة.
زعامة بودي في الهند، وبوتين في روسيا، وأردوغان في تركيا، والأربع أو الخمس زعماء في أوروبا، وأخيراً وليس آخِراً رئاسة الرئيس دونالد ترامب، هي النتاج الحاضر لهذه العوامل مجتمعة.
قد تبيّن أنّ إحساسات الانظلام والتهميش لا تقتصر على الملوّنين والمهاجرين والأقليات، بل تدخل فيها فئات بيضاء على حواشي المدن أُخرجت من مجرى سيل العولمة المندفعة
هل للحشد الشعبوي المتعملق في كل مكان “هويّة”، أي “جوهرٌ” يمكن تحديده؟
العلوم الاجتماعية الحديثة لا تبحث عن الجواهر بل عن الظواهر. لكن هناك من المراقبين من التمس ذلك في الدين، بينما التمسه آخرون في الإثنية والقومية، والتمسه فريقٌ ثالثٌ في سيطرة وسائل الاتصال الديجيتالية. إنّما الذي يجمع ذلك كله، ويتمحور حوله أمران: الزعامة الكارزماتية، وقوة الشرعية التي ما تزال متمثلةً بالدولة، ووسائل إرغامها (المشروعة). فإذا “نجح” الزعيم الكارزمي في الاستيلاء على قوّة الدولة وشرعيتها، فإنّه يتحول إلى قوّة أسطورية.
كلّ الفئات تتهيّب من سلطة الدولة الإرغامية، لكنّها بقدر ما تخشاها وتتذمر منها فإنّها تخاف عليها، خشية الفوضى والضياع. الرئيس بوتين لاذ به الروس بعد أن هدّدتهم الفوضى. ورئيس الوزراء الهندي لاذتْ به العامة الهندوسية رجاء تحقيق ما لم يمكن تحقيقه في آلاف الأعوام. والشعبوية (شعبوية الحرافيش والمهمّشين) رأت في دونالد ترامب رجل أعمالٍ ناجحاً وقوياً بكل المقاييس، فمشت وراءه باتجاه الرئاسة. والرئيس أردوغان وبخليطٍ من شعبوية الدين والقومية والنجاح الاقتصادي صار زعيماً أوحد.
لا يستطيع الزعيم الكارزماتي أو الذي يُنظر إليه باعتباره كذلك، الخضوع لأعراف الدولة وقوانينها. إذ هو إنما جاء لتحقيق ما لا تستطيع إدارات الدول في العادة أن تحققه. فهو يستخدم قوة الدولة البيروقراطية والعُرفية لتحطيمها على وقع استحسان جمهور الحشد. ومن بين الذين ذكرناهم فقد كان الرئيس بوتين هو الأكثر نجاحاً حتى الآن. ذلك لأنّه جاء بعد إمبراطورية السوفيات الحديدية، وبعد فوضى ضاربة، فاستطاع بكلّ سهولة، وباستحسان شعبي منقطع النظير، أن يفعل ما يشاء وبدون مقاومة. الدستور تغيّر، والقوانين تغيّرت. وهو شارك ويشارك بجيوشه في حروبٍ عديدة ينتصر فيها كلّها، ويجد تهليلاً شعبياً، ما كان السوفيات يحظون به رغم انتصارهم في الحرب العالمية الثانية. إنّما هل صارت أوضاع الناس أفضل؟ بالطبع لا. لكنّ المواطن الروسي راضٍ حتّى الآن عن الاستقرار، وعن الفتوحات.
الشعبوية (شعبوية الحرافيش والمهمّشين) رأت في دونالد ترامب رجل أعمالٍ ناجحاً وقوياً بكل المقاييس، فمشت وراءه باتجاه الرئاسة. والرئيس أردوغان وبخليطٍ من شعبوية الدين والقومية والنجاح الاقتصادي صار زعيماً أوحد
وكان الأمر أصعب على أردوغان. فالدولة التركية قوية بمؤسساتها وإن لم تكن ناجحةً اقتصادياً. لكنّه لم يصبر على نجاحه، بل ومن أجل تخليد حكمه، انتهز فرصة محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، وعمد إلى تكسير الجيش والقضاء والتعليم والإعلام وأعراف الوظيفة العامة، باعتبار هؤلاء جميعاً أعداءً لشعبه الخاصّ الحبيب. وكما يخوض حروباً بالداخل ضد الجميع (بما في ذلك أخيراً ضدّ طلاب ما رضوا برئيس الجامعة الذي عيّنه لهم)، يخوض حروباً في المحيط الجغرافي بحجّة استعادة المدى الحيوي والاستراتيجي لتركيا. على الرغم من أنّ الاقتصاد يتراجع، ورؤوس الطبقة الوسطى في السجون. فهل يبقى؟ سيبقى بالطبع، وإذا فشل في الانتخابات فإنّه يستطيع إعادتها كما فعل مع بلدية اسطنبول.
وأخيراً فإنّ الرئيس ترامب كان الأكثر نجاحاً، وهو اليوم الأكثر فشلاً. ليس الحزب الجمهوري هو الذي أوصله إلى الرئاسة، بل هو الذي استعاد السلطة للحزب، وبشعبويته. لكنّ الدولة الأميركية غير الدولة الروسية والتركية. فهي راسخة المؤسسات وراسخة التقاليد. وقد كانت رئاسته قوية لأنّ الدولة الأميركية قوية. وكل الوقت تعامل مع العالم، وحتّى مع الصين، باعتباره يريد كسب المال لأميركا أوّلاً. لكنّه مثل كل الكارزماتيين، لا يؤمن بالقانون ولا بالمؤسسات. ولذلك أراد أن يبقى في السلطة شأن بوتين وأردوغان. وعندما لم يستطع ذلك حاول ضرب المؤسسة الرئيسية في الدولة: الكونغرس. فسقط خلال أربع ساعات، جالباً العار على نفسه وعلى الحزب الجمهوري.
وما أساء ترامب إلى المؤسسات بقدر ما أساء إلى المعنى الكبير لأميركا، المدينة “الفريدة” على الجبل، بحسب الإنجيل (أنظر كتاب طارق متري). هذا الرأسمال الرمزي الكبير ضيّعه ترامب في الداخل حتى لدى رجال الأعمال الكبار الذين يُقال إنّه متحالف معهم. أما مع الخارج فحدّث ولا حرج. التفوّق الاخلاقي الأميركي يستبطن الهيمنة بطبيعته، لكن ترامب أراد ثمناً مادياً في مقابل الهيمنة أو ينسحب ويقفل الباب وراءه، وليس مع الصين مثلاً بل مع أوروبا وكندا والمكسيك أيضاً. قال ترامب إنّه أعظم رؤساء أميركا وإنّه هو المنقذ فأجابه أوباما “نعم أنت تريد إنقاذ أميركا من ذاتها”.
إقرأ أيضاً: 2021: هل هو عالم ما بعد أميركا حقاً؟!
هل انتحار ترامب انتحارٌ للشعبوية؟
في العام 2004 أصدر فريد زكريا، الأميركي الهندي الأصل، كتاباً عنوانه: “الديمقراطية الشمولية”. وهو يعني أنّها نظام سياسي يجمع حشداً مليئاً بالمطامع والمطالب والكراهية فيفوز في الانتخابات، ويحكم كما يريد. وبذلك تنكمش الديمقراطية إلى الانتخابات وليس أكثر. فوكوياما يسمّي الظاهرة: “الديمقراطية غير الليبرالية”. لقد ثبت أنّ ذلك غير ممكن في الولايات المتحدة بالذات. فالديمقراطية هي انتخابات وزيادة، هي الدستور والقوانين وإدارات الولايات والبيروقراطية الشديدة التمسّك “بحقوقها”، ورجال الأعمال الكبار الذين استخدموا ترامب واستخدمهم، لكنهّم ليسوا مستعدين للخضوع للحرافيش المخيفين.
العالم الغربي الذي عرفناه بعد الحرب الثانية بالذات ينتهي، والطبقات الوسطى التي صنعته تتآكل. وبعد عقدٍ أو عقدين لن نجد أحداً مثل ميركل أو ترودو أو حتّى جونسون وماكرون.
لقد ذهب ترامب، لكنّ الأميركيين لن ينسوا احتلال الكونغرس، كما أنّ العالم لن ينسى أنّ الديمقراطية الأميركية أيضاً يمكن أن تتعرّض للتجربة.