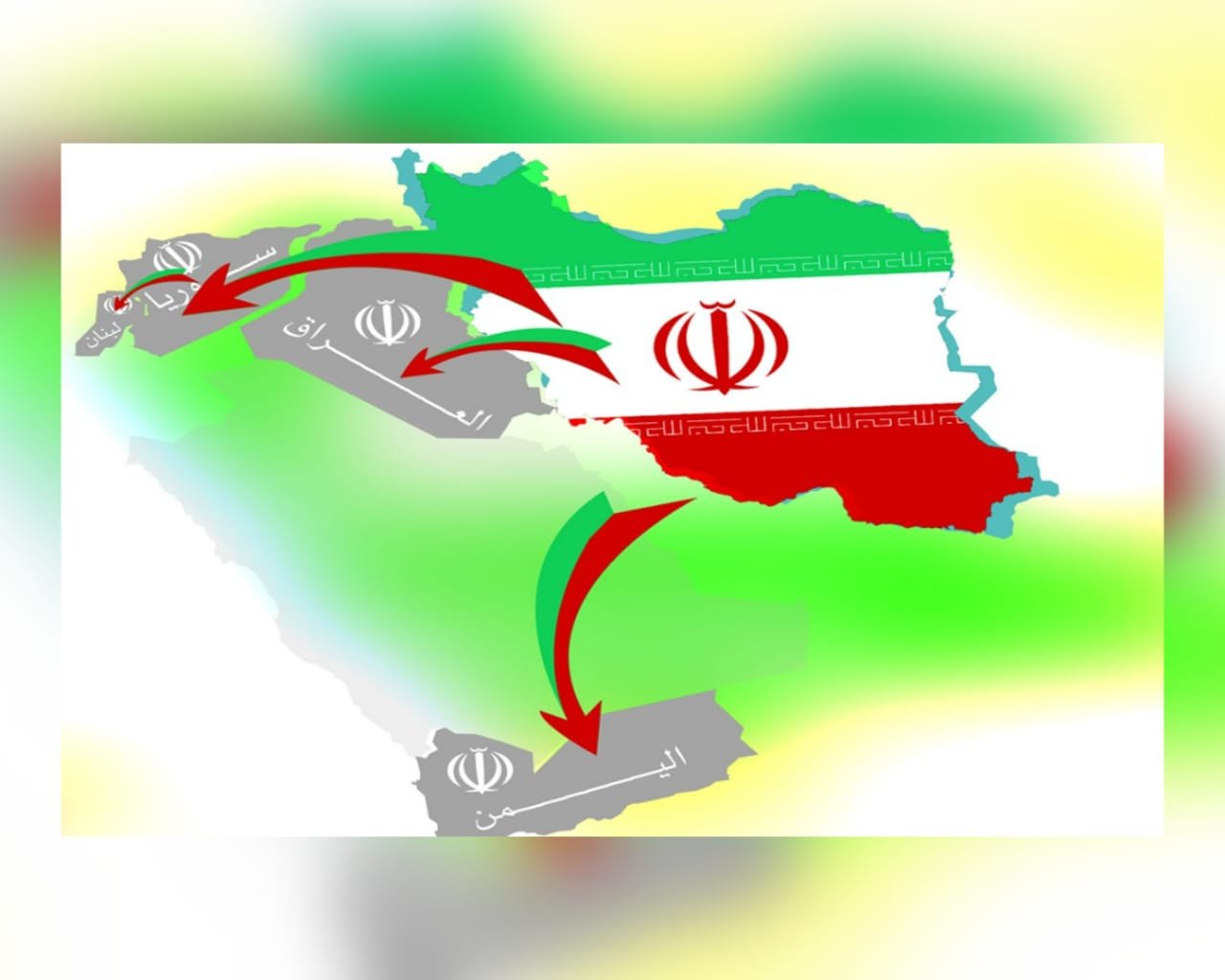تختلف تقديرات الاستراتيجيين (وليس المعلّقين في الفضائيات) بشأن العام 2020 الذي انقضى ولن تنقضي كوابيسه وانهياراته لعقدٍ أو أكثر في عمر العالم. منهم من يقول إنّه أسوأ الأعوام منذ انهيار البورصات عام 1929. والواضح أنّ هذا التقدير الذي يقول به ثلاثةٌ من الحاصلين على جائزة نوبل للاقتصاد (ستغلتز، وأماراتيا صَن، وبول كروغمان) إنّما ينظر إلى الجانب الاقتصادي. في حين يذهب آخرون معنيون بقضايا الحرب والسلام إلى أنّ العام المنقضي كان أسوأ الأعوام على الدول المتقدمة، بالذات منذ العام 1945، عام نهاية الحرب العالمية الثانية.
أما Stephanie Zacharek، الأستاذة المعروفة في استراتيجيات الإعلام ووسائل الاتصال، فتعتبر عام كورونا أسوأ الأعوام على العالم على الإطلاق، لثلاثة أسباب: العجز العلمي والطبي الفاضح في مواجهة الوباء وتداعياته على الحياة البشرية وعلى أسلوب العيش في العالم. وهي تقدّر أنّ هذا الأمر أو انعدام الحيلة ما حدث شبيه له منذ طواعين العصر الوسيط (1349) في أوروبا وآسيا. والطريف أنّ الطاعون يومها انطلق من الصين. وبسبب العجز عن التعاون من جانب الكبار فيما بينهم من جهة، ومع العالم من جهةٍ ثانية. بل وانطلاق النزعات العدوانية تجاه الآخرين الذين كان ينبغي أن يكونوا شركاء. وهي تقصد بذلك بالدرجة الأولى الرئيس دونالد ترامب. لكنّها لا تستثني الصين وروسيا واليابان والهند ودول الاتحاد الأوروبي. وتقصد تصاعُد نزاعات التوتر وبإثارةٍ أو إثارات من جانب الكبار والأوساط ضدّ الصغار الأكثر عجزاً والأقلّ حيلة (Time : The Worst Year Ever).
Stephanie Zacharek، الأستاذة المعروفة في استراتيجيات الإعلام ووسائل الاتصال، تعتبر عام كورونا أسوأ الأعوام على العالم على الإطلاق
بيد أنّ رئيس تحرير Economist (في العدد السنوي لتوقعات العام 2021) يشير إلى تداعيات تستدعي التأمل فيما وراء الاستحسان والإدانة، وتتلخص في ثلاث حقائق أيضاً: العولمة، عولمة السوق صارت أكثر عمقاً. والثورة الديجيتالية، وقد صارت أكثر تسارعاً، والعداوة بين أميركا والصين وقد صارت أكثر وضوحاً وتعدداً وامتداداً.
في الاقتراحات (المتفائلة) التي قدمها كُتّاب الـEconomist لعام 2021 هناك تجنبٌ لافتٌ للحديث عن الدور الأميركي والإمكانيات الأميركية. هناك حديثٌ مستفيضٌ عن الدور الأوروبي مخلوطاً بالأسى على غياب المستشارة ميركل. والدور الأوروبي لا يقتصر على الاقتصاد. الاقتصاد مثقلٌ في أوروبا، لكنّ غياب البريطانيين يُعتبر خلاصاً وليس ضعفاً. فالبريطانيون سيظلّون بحاجة للأوروبيين، خصوصاً فرنسا وألمانيا. وغياب ميركل سيشجع هذا الاقتصاد القوي على المزيد من التمحور. لكنّ ألمانيا ملتزمة بشدّ أزر الدول الثماني والعشرين بالاتحاد. والألمان لا يعانون من عقدة الزعامة التي تتحكم بفرنسا وبماكرون. ولذلك ترى أورسولا فون دير لاين معتمدة الاتحاد الأوروبي والدور على ألمانيا هذه المرة، أنّ أوروبا تستطيع التوجه نحو أميركا بوجهٍ جديد، وبدعوةٍ متجددة للمشاركة في التبادل التجاري المنصف، وفي السياسات الأطلسية، وفي الشراكة المتطورة على مستوى حفظ سلام العالم، والأهمّ بالوساطة والاتصال مع الصين ومع روسيا. والسيدة فون دير لاين ليست متوهّمة، فمطالب ترامب من الصين لن تختفي بعده، ولذلك يمكن للاقتصاد المتعدد الأضلاع أن يُرغم الصين على تبادُلٍ أكثر توازناً. وفون دير لاين لا تخشى التحدي العسكري والأمني الروسي. فالروس في أشدّ الحاجة للتعاون الاقتصادي. وهناك سبعة آلاف شركة ألمانية وأوروبية تعمل في روسيا. وهناك أيضاً خطّ الغاز الجديد الذي يربط روسيا بألمانيا وهو شريان حيوي للروس. ومن طريق استراتيجية الاعتماد المتبادل تستفيد روسيا كثيراً، وتضطرّ للإصغاء إلى الرغبات الأوروبية في خفض التوتر بشرق أوروبا. ومنطق فون دير لاين: إذا أردتَ أن تُطاع فاطلب المُستطاع.
هل تتضاءل بذلك المشكلات أو نقاط التصادم؟
مع روسيا نعم، أما مع الصين فإنّ مسار التفوق عندها يجعل الأمور أكثر صعوبة. لكنّ الصين تعبت أيضاً من الصراع مع أميركا، ومن التذمّر الأوروبي والياباني والهندي. ومنذ العام 2018 لا تنفق الصين على استراتيجيتها الكبرى في “الحزام والطريق”ّ إلاّ 50% مما كانت تنفقه في آسيا وإفريقيا. فالوساطة والشراكة المنصفة هما عنوانا الدور الأوروبي المقبل.
أما اقتراحات المجلة الشهيرة الأخرى فتدور كلها على التعاون والتضامن. والداعون هم أمين عام الأمم المتحدة، وأمين عام منظمة الصحة العالمية، والاقتصادي الكبير راينهارت، والإعلامية الكبيرة تامارا روخو.
رئيس تحرير Economist يشير إلى تداعيات تستدعي التأمل فيما وراء الاستحسان والإدانة، وتتلخص في ثلاث حقائق أيضاً: العولمة، عولمة السوق صارت أكثر عمقاً. والثورة الديجيتالية، وقد صارت أكثر تسارعاً، والعداوة بين أميركا والصين وقد صارت أكثر وضوحاً وتعدداً وامتداداً
كيف يتجلّى التضامن في الاقتصاد؟
بالإنفاق الكثيف والإقراض الكثيف، ومن الدول والمؤسسات. هناك تركيز على التعاون البيئي، وعلى الإنصاف في توزيع لقاحات كوفيد-19 على مليارات الناس في العالم، وستون بالمائة منهم من الفقراء.
ما عاد هناك كلام على إلغاء الدول أو تصغير حجمها شأن مزاعم النيوليبراليين، فقد أفلتت السوق من الدول، واستعصت عليها، وصارت الشركات تسخّر الدول، حتّى الكبرى منها، لبلوغ الأرباح الضخمة الموهمة بالتفوق الاستراتيجي. هناك تعددية قطبية ينبغي أن تتعامل فيما بينها على قدم المساواة بقدر الإمكان، وعندما يحدث ذلك، تعود الروح للنظام العالمي.
ولننصرف إلى الموضوع الآخر الذي تغصُّ به المؤلفات الجدية والمقالات الجدية والمقابلات مع كبار الاستراتيجيين، وهو: متغيّرات الدور الأميركي في عالم اليوم، والتناطح بين أميركا والصين، وليس في الاقتصاد والسوق والحجم، بل وفي المديات الاستراتيجية العسكرية والأمنية، واستراتيجيات الشركات العظيمة.
منذ عشرين عاماً يجري الحديث عن “عالم ما بعد أميركا” وقد اشتهر بهذا العنوان الكاتب الأميركي الهندي الأصل فريد زكريا، الذي كان محرّراً لمجلة “نيوزويك”. وقرأْتُه لكاتب يميني آخر هوروبرت كابلان. وبين يديَّ أحدث كتابٍ عن الموضوع للاستراتيجيين الفرنسيين الشهيرين برتران بادي ودومينيك فيدال. عنوان السلسلة السنوية: “أوضاع العالم”، أما كتاب العام 2020 فهو بعنوان: “نهاية الزعامة الأميركية؟”. وتوقعات النهاية أو نُذُرها لا تستند وحسب إلى التوسع الشاسع للإنتاج الصيني في كل السِلَع، بل وإلى التقدم السريع جداً في المجالات التكنولوجية والاتصالية والفضائية والعسكرية. وبعد أن كانت التوقعات تشير إلى أنّ الاقتصاد الصيني سيصبح الأوّل في العالم في 2040، صار الأوروبيون يقولون الآن: خلال عشر سنواتٍ أو أقلّ سوف يحدث ذلك! وترامب ما صارع الصين وشركاتها على الفائض الضخم بداخل السوق الأميركي، بل صارعها أيضاً على التحديات في بحر الصين، وفي المحيط الهندي، وبدعم تايوان، وبالتقرّب من فيتنام والهند. بل وفرض عقوبات ليس على “هواوي” وشركات أُخرى فقط، بل تحدّاها في هونغ كونغ، وبسبب الأويغور بسنكيانغ. وبالطبع فإنّ الحيلولة بين الصين والسوق الأميركي، سيحرم الصين من تجارةٍ بثلاثمائة مليار دولار. لكنّ المنتجات الصينية اجتاحت آسيا وإفريقيا (وبالطبع إلى جانب الهند وحتّى تركيا). وهي تنافس في السوق الأوروبية. وهذا فضلاً عن أساطيلها في بحر الصين والمحيط الهندي. وصحيح أنّ الأميركيين لديهم أساطيل حربية وحاملات طائرات وقواعد في كل مكان، وليس في الجزيرة العربية ودول الشرق الأوسط فقط، لكنّ الصينيين عندهم أصدقاء في كل مكانٍ في القارتين، وهم يبيعون ويشاركون في التنمية، ولولاهم لما استطاعت إيران الصمود. ما عادت أميركا تستورد الطاقة، لكنّ شركاتها والشركات الأوروبية ما تزال مسيطرة على أسواق التوزيع. أما الصين فصارت المستورد الأوّل في العالم للطاقة، وتأتي بعدها الهند، وتأتي أوروبا ثالثاً. وهي فضلاً عن ذلك اشترت منابع وموانئ وخزانات بحرية في عشرات الدول والبحار، وتملك شبكةً هائلة من أساطيل النقل.
لماذا هذا التطويل في ذكر امتدادات الصين؟
لأنّ الباحثين الاستراتيجيين ومنذ عقدٍ وأكثر ركّزوا على هذا التسارُع الصيني الاقتصادي والعسكري، وكانوا يعتبرون أنّ العام 2020 سيشكّل خطوةً واسعةً إلى الأمام، وفي جانبين: الجانب الاقتصادي، وجانب ما صار يُعرف بـ”المدى الحيوي”. أما الجانب الاقتصادي فقد تباطأ بسبب كورونا، وبسبب إجراءات ترامب. وأما المدى الحيوي (بحر الصين الجنوبي) فإنّ الأساطيل الأميركية ما غابت عن تلك البحار، وزحفت بحراً وجوّاً بكثافة. وقبل أسابيع أجرت الصين مناوراتٍ هائلة بالاشتراك مع الروس في البحر والبرّ والجو. وبالطبع ما جرى التصادم، إنما توقف الطرفان بدون تقدمٍ ولا تأخر.
المنتجات الصينية اجتاحت آسيا وإفريقيا (وبالطبع إلى جانب الهند وحتّى تركيا). وهي تنافس في السوق الأوروبية. وهذا فضلاً عن أساطيلها في بحر الصين والمحيط الهندي
هذا هو التحدّي الأكبر الذي تواجهه الولايات المتحدة. والذي صار يؤثر في حساباتها الاستراتيجية منذ زمنٍ طويل. لكنّه باستثناء إنجاز قيادة “أفريكوم” العسكرية، ما اتخذ منحىً استراتيجياً أو تحوّلاً استراتيجياً إلاّ في الحديث أيام أوباما. فقد انشغل الأميركيون عن التحدّي الصيني قبل ترامب بثلاثة أمور: العودة الروسية بعد العام 2007 للإزعاج في أوروبا والشرق الأوسط، ومكافحة الإرهاب، وترتيب الملف النووي الإيراني. وما نجحوا لا في استيعاب روسيا، ولا حقّقوا نتائج يُحسب لها حساب في الميزان الاستراتيجي في غزو أفغانستان والعراق، وتورّطوا أكثر من اللازم في المفاوضات والمماحكات مع إيران، وخسروا باكستان لصالح الصين، ويوشكون على خسارة أفغانستان والعراق وتركيا.
يقول هنري كيسنجر: “الرئيس أوباما صاحب أفكارٍ كبرى، وأفعال صغرى”. فحتى الضمان الصحي بالداخل ما استطاع إنجازه تماماً. لكن أيام أوباما قيل إنّ هناك تحولاً باتجاه مواجهة التحدي الصيني الجيواستراتيجي، والجيواقتصادي. فلنفرغ من تحدّي الإرهاب، والنزاع مع إيران، وحلّ المشكل بين إسرائيل والفلسطينيين، لكي تتحوّل الجيوش والقواعد وتكتيكات الشركات بالاتجاه الصيني. هناك طاقاتٌ هائلةٌ وُضعت لمكافحة الإرهاب، وقد حقّقت نتائج، وفيما عدا ذلك ما تحقق شيء، بل ضاعت أشياء كثيرة.
بدأ ترامب من الآخِر وبدأ يتحدى الصين، وضغط كثيراً دون أن يخوض حرباً. لكنه خَلّف – بضغوطه الفاضحة وغيرالمتلائمة بالداخل الأميركي وعلى الحلفاء والأصدقاء والمؤسسات الدولية والخصوم بالخارج – على الولايات المتحدة تحديات تكاد تُضاهي في هولها وعمقها التحدي الصيني.
نعم، عندما يتحدث الاستراتيجيون والسياسيون الأميركيون اليوم عن عالم ما بعد أميركا، لا يذكرون الصين فقط، بل يذكرون الانقسام العميق في المجتمع الأميركي (حصل بايدن على ثمانين مليون صوت، وحصل ترامب على 74 مليون صوت)، ويذكرون شرذمة المؤسسات وتفكّكها، والتخريب الواقع في الجهات الفدرالية، وحتّى في الولايات. ويذكرون افتقاد أميركا الحلفاء والأصدقاء في الأطلسي، وفي اتفاقية التجارة مع المكسيك وكندا (نافتا)، كما يذكرون خروج الهيبة الأميركية والاعتبار الأميركي مع الخروج من اتفاقية المناخ، ومن الاتفاق النووي مع إيران، والغربة مع لجنة حقوق الإنسان، ومع اليونيسكو، ومع منظمة الصحة العالمية.
وبالنظر إلى ذلك كلّه كان عنوان مجلة “فورين أفيرز” الأخير عام 2020: “هل تستطيع أميركا أن تتعافى؟ Can America Recover”. ومن استعراض مقالات المجلة الاستراتيجية يتبين أنّ معظم الاستطلاعات تدور حول الداخل الأميركي (باستثناء مقالة عن المشكلات في الحزب الشيوعي الصيني، وأخرى عن الربيع العربي المنقضي). سامانثا باور التي كانت مهمةً في إدارة أوباما، وما تزال منحازةً إليه، تذهب في مقالتها، كما يذهب رئيس تحرير “الأكونومست”، إلى أنّ الرئيس بايدن هو الرجل الصحيح، لكنْ هل أتى في الزمن الصحيح؟!
أما الفرنسيان برتران بادي ودومينيك فيدال، فهما شامتان على عادة الاستراتيجيين الفرنسيين الذين لا يحبون أميركا. وهما يتوقعان دماراً في الحزب الجمهوري، واندثاراً في التوازن الداخلي بين مجلسَي الكونغرس والنواب. لكنّ الكاتب المعروف ولتر راسل ميد يذكّر بضخامة القوة الأميركية الداخلية، وسمعة أميركا الهائلة في العالم. فأميركا صنعت العالم المعاصر بقيمه ومؤسساته وأساليب الحياة فيه. وقد صارت “الأميركية” نزوعاً عالمياً وإنسانياً عاماً. بيد أنّ أطرافاً كثيرة أحسنت التقليد وتفوّقت فيه، وإن لم يستطع أحد اقامة مجتمع ودولة مثل الولايات المتحدة التي نموذجها المدينة الواقعة على رأس جبل، كما في الإنجيل. ويذهب ميد أخيراً إلى أنّ بايدن بشخصيته المطمئنة قد يتمكن من استعادة الثقة والهدوء بالداخل، لكنّه لا يظن أنّ الثقة الخارجية بأميركا يسهُلُ استعادتها، سواء لدى الأصدقاء، أو لدى الخصوم.
إقرأ أيضاً: بايدن “البعثي”: هذا ما سيفعله مع إيران
إذا كان عالمنا اليوم هو عالم ما بعد أميركا حقاً، فإنّ صورته هي صورة الفوضى العارمة، والتي لم يصنعها ترامب وحده بالطبع، بل أسهمت في صنعها دولٌ صارت أقطاباً، وأخرى تطمح إلى أن تكون كذلك. فإذا كان عالم اليوم (هو عالَمُ ما بعد)، فسيكون هو عالم ما بعد “هيمنة” أميركا لا أكثر ولا أقلّ: {وتلك الأيام نداولها بين الناس} ( سورة آل عمران: 3).