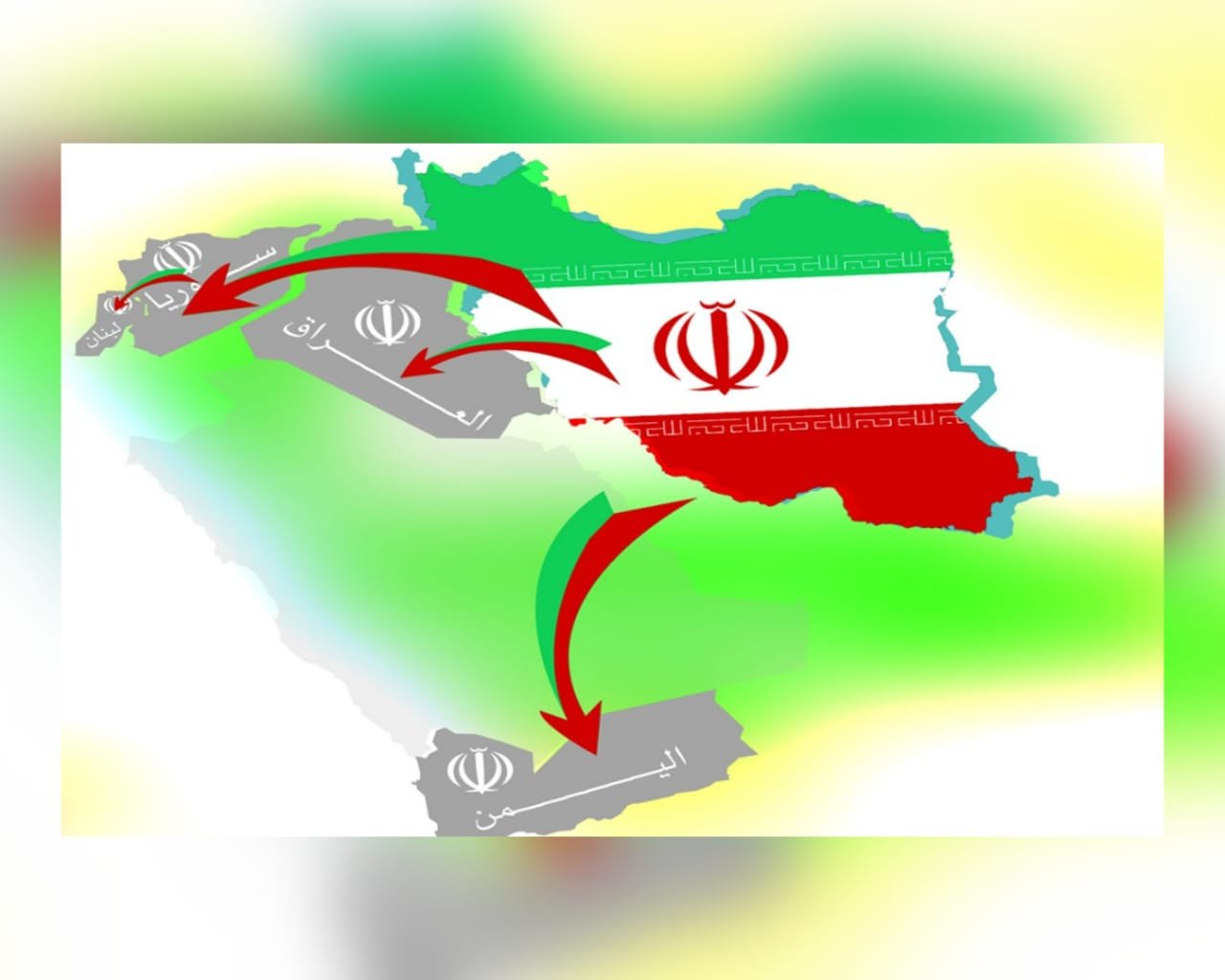لا يحتاج المرء إلى الكثير من التفكير ليدرك أنّ الخروج من فلسطين في عامي 1948 و1967 هو غير خروج السوريين من بلادهم نحو تركيا ولبنان والأردن وأوروبا بين 2013 و2017. الفلسطينيون اقتُلعوا اقتلاعاً. أما السوريون فإنّهم هاجروا أو هربوا، ولا فرق في ذلك سواء ذهبوا إلى تركيا أو ألمانيا أو الجزائر أو لبنان. الفلسطينيون كانوا في معظمهم مُرغَمين، أما السوريون فإنّ نصف مهاجريهم أو هاربيهم على الأقلّ (وبخاصةٍ الذين ذهبوا إلى تركيا وألمانيا) ما أُرغموا على ذلك بتهجير ميليشيات بشارالأسد أو الزعيم المعصوم. هي خمسون عاماً وأكثر من التعذيب والإفقار والتنكّر لإنسانية الإنسان، والتي أفقدت هؤلاء الناس إحساسهم بأنهم ينتمون إلى هذه الدولة وهذا النظام.
إنّ الذي أذهبُ إليه أنّ معظم مهاجري العقد الأخير من البلدان العربية والإسلامية، إنّما يبحثون عن وطنٍ بديل، بعد أن ضاع منهم انتماؤهم التاريخي العريق. وبالطبع لن يحصلوا عليه!
عندما كتب عالم السياسة المصري نزيه الأيوبي كتابه عن تضخّم وانسداد الدولة العربية (1994)، كان هذا هو الذي قصده. لقد فشلت تجربة الدولة الوطنية العربية، وهذا أمرٌ أفدح من القول إنّ النظام فقد شرعيته أو صارت شرعيته منقوصة. فماذا فعلت النُخَب العربية القومية / الوطنية والإسلامية. النخبُ المحدَّثة انصرفت للدعوة إلى دمقْرطة الأنظمة العربية. أما النخب الإسلامية ومنذ الستينات، فقد دعت إلى الاستبدال بالدولة الوطنية العربية دولةً إسلامية. وقِوام الدولة الإسلامية: نظام العدالة الكامل بتطبيق الشريعة التي لم يعرف أحدٌ معناها بالتحديد حتى اليوم. كان هَمُّ مفكّري الإسلاميين الوصول إلى السلطة من طريق تكفير الأنظمة الوضعية التي يريدون أن يُحلُّوا محلَّها دولةً أُخرى قالوا للجمهور إنها دولةُ السلف الصالح، والتي لا تتحقّق إلا بتطبيق الشريعة، وتطبيق الشريعة واجبٌ دينيٌّ لا يستطيع القيام به وعليه غيرهم! وقد أمكن لهذه المقولة العقائدية أن تُسقط الدولة الوطنية الإيرانية، لصالح نظام ولاية الفقيه، وهو المقارِن لنظام تطبيق الشريعة عند أيديولوجيي السنّة من الإخوان والصحويين وغيرهم.
إنّ الذي أذهبُ إليه أنّ معظم مهاجري العقد الأخير من البلدان العربية والإسلامية، إنّما يبحثون عن وطنٍ بديل، بعد أن ضاع منهم انتماؤهم التاريخي العريق. وبالطبع لن يحصلوا عليه!
هل جاء النظام الديني الإيراني بحلٍّ أو حلول؟
بالطبع لا.
ولو انفتحت الحدود، لوجدنا ملايين فقراء الشعب الإيراني ومقتلَعيهم، يفعلون ما فعله ملايين السوريين. وعلى ذلك، فإنّ متابعي التطوّرات في إيران عبر أربعة عقود، يقولون إنّ خمسة ملايين رغم الانسداد، بل الانسدادات، استطاعوا المغادرة بطريقةٍ أو بأُخرى!
السوريون وغيرهم خرجوا أو أُخرجوا بدون ثقافة مواطنة أو ممارستها. ما عرفوها من خمسين سنة في الدولة المتوحّشة في ظلّ آل الأسد. والذين كانت لديهم هوامات دينية بشأن المجتمع الفاضل، مجتمع تطبيق الشريعة، انتظروا أن يلقوا شيئاً من ذلك حيث يصلون. ولا شكّ أنّ كثيرين منا سمعوا عجائب الإعجاب عما لقوه ويلقونه في ألمانيا. بل إنّني سمعتُ الكثير الكثير عن فضائل الإقامة بتركيا، وعن استماتة القادرين منهم للحصول على الجنسية التركية. وقد تحدّثتُ إلى العديد من السوريين المقيمين بقريتنا والقرى المجاورة، وهم يعتبرون ما هم فيه حسناً جداً بالمقارنة مع ما كانوا فيه. وما ذكر أحدٌ منهم أنه هُجِّر، بل قال إنه جاع، وكان جائعاً قبل الثورة السورية وبعدها! لكنه ما يزال يُحسُّ بالغربة، ويتهم اللبنانيين والأتراك بأنهم أنانيون ولا يراعون مخاوفه!
ما الذي أُريد الوصول إليه؟
الذي أريد الوصول إليه، أنّ هؤلاء الذين هاجروا من سورية أو من غيرها في السنوات الأخيرة، ما عرفوا ولا عاشوا ثقافة المواطنة بحقوقها وواجباتها. وهم جميعاً في المجتمعات الجديدة يشعرون أنّهم في وضعٍ أفضل بكثير. لكنهم يشعرون أيضاً بالغربة الشديدة للأعراف والعادات وحتى ثقافة القانون المختلفة. هم لا يحنُّون، ولا يريدون العودة من المهاجر إلى وطنهم أو أوطانهم، لكنهم يفتقدون ما يمكنهم اعتناقه غير سدّ الجوع والثياب والمدارس للأطفال.
هل هم مُحقُّون في هذه المشاعر؟
لا حقَّ ولا باطل في ذلك. بل الأمر في الأعطاب التي نالت من إنسانيتهم في أوطانهم، وما استطاعوا تعويضها في هجرتهم، وقد لا يستطيعون. المهاجرون القُدامى الذين استقبلتهم أوروبا أفضل، لأنّ سوق العمل كان بحاجةٍ إليهم، وقد احتاجوا إلى جيلٍ أو جيلين، ليعودوا فيكتشفوا الوطنين الجديد والقديم. وقد ضاق العالم الآن في كلّ مكان، ولا أحد قادر أو مريد اليوم للاستقبال أو الإمهال!
لقد أحسستُ إحساساً عميقاً بما كان الرئيس الفرنسي يحاول قوله عن مجتمعات الانفصال. فهذا هو المخرج الذي ارتآه الأيديولوجيون الإسلاميون من الإخوان وغيرهم لهؤلاء الغرباء المُلتاعين: الحفاظ على الهوية الخاصة والحميمة وهي دينيةٌ بالطبع. أنت لا تستطيع العيش بدون رموزٍ ومعنى لإنسانيتك، في الملبس، والمأكل، والمسجد، والتقاليد الباقية للأُسرة، واللغة، والخطاب، والصحبة. وهذه كلها بالطبع أمورٌ لا يُحسُّ بها الذين وردْتَ عليهم، بل وينكرونها عليك، ليس في فرنسا وألمانيا وحسْب، بل وفي تركيا ولبنان أيضاً.
الذي أريد الوصول إليه، أنّ هؤلاء الذين هاجروا من سورية أو من غيرها في السنوات الأخيرة، ما عرفوا ولا عاشوا ثقافة المواطنة بحقوقها وواجباتها. وهم جميعاً في المجتمعات الجديدة يشعرون أنّهم في وضعٍ أفضل بكثير
في بلدك كنتَ تطالب بنظامٍ سياسيٍّ آخر، وبتطبيقٍ للشريعة. وفي فرنسا، بل وفي لبنان وتركيا، ليس بالوسع صنع نظامك الخاص، فليكن الأمر الآخر: أمر الهوية المتركّزة حول الدين والتديّن وشعائرهما ورموزهما. وهذا بحدّ ذاته انفصالٌ وانكماش يطمئنك إلى استمرار وجودك الخاص، لكنه لا يطمئن ولا يُرضي المجتمع الأوسع من حولك! ثم إنّه يوهمك بالتحصّن، ولا حصانة في الحقيقة إلاّ بحقوق المواطنة وثقافتها!
كنتُ في إحدى مقالاتي في “أساس” أو في “الشرق الأوسط”، ذكرتُ حديثي مع الرئيس شيراك عام 2003 عندما صدر قانون منع الحجاب في الأماكن العامة عن البرلمان الفرنسي، قلت له: “هذا شأنٌ خاصٌ ماذا تلبس المرأة أو لا تلبس، وهي لا تمارس العنف أو الإرهاب فلماذا هذا التضييق؟”. وقد أجابني يومها: “لأنكم كثيرون كثيرون”!
إقرأ أيضاً: نحو سردية جديدة للإسلام (3/3).. مقاصد الشريعة: الرحمة والتعارف
نعم، المسلمون الفرنسيون ليس عددهم كما يقول الرئيس ماكرون ستة ملايين، ربما كانوا كذلك قبل عشرين عاماً. وهذه الخصوصيات المطمئنّة، ولو إيهاماً، على الهوية الخاصة، إذا عمّت في أوساط مليونٍ أو مليونين، من هؤلاء المسلمين المنتشرين في كلّ مكان، تبعث على الإقلاق بالفعل، لأنّها تصنع مجتمعاتٍ صغيرةً منفصلة ومتفاصلة على مدياتٍ متطاولة.
لا يستطيع الرئيس الفرنسي أن يحلَّ المشكلة، لا بتغيير الثقافة الإسلامية، ولا بقوانين الأمن الشاملة. لكنّ المشكلة لا تُسألُ عنها فرنسا وحدها، بل هي نابعةٌ أساساً من المواطن الأصلية لهؤلاء المهاجرين، حيث فُقدت ثقافة المواطنة، وثقافة إنسانية الإنسان. وعندما يصبح المرء غريباً في وطنه، يظلُّ غريباً حيثما ذهب: فلنستِعدْ أوطاننا من طريق استنقاذ وتجديد تجربة الدولة الوطنية العربية، بحيث يأمن إنساننا في وطنه، فيأمن في العالم، ويأمن العالم به ومعه.
إنّ ظلت أوطاننا غير صالحةٍ للحياة البشرية، فسنظلّ غرباء وخائفين في أيّ مكانٍ توجّهنا إليه، وسيظلّ الآخرون متوجّسين منّا. وإّنما غاية الأماني أن لا نخاف من العالم، ولا نخيفه!