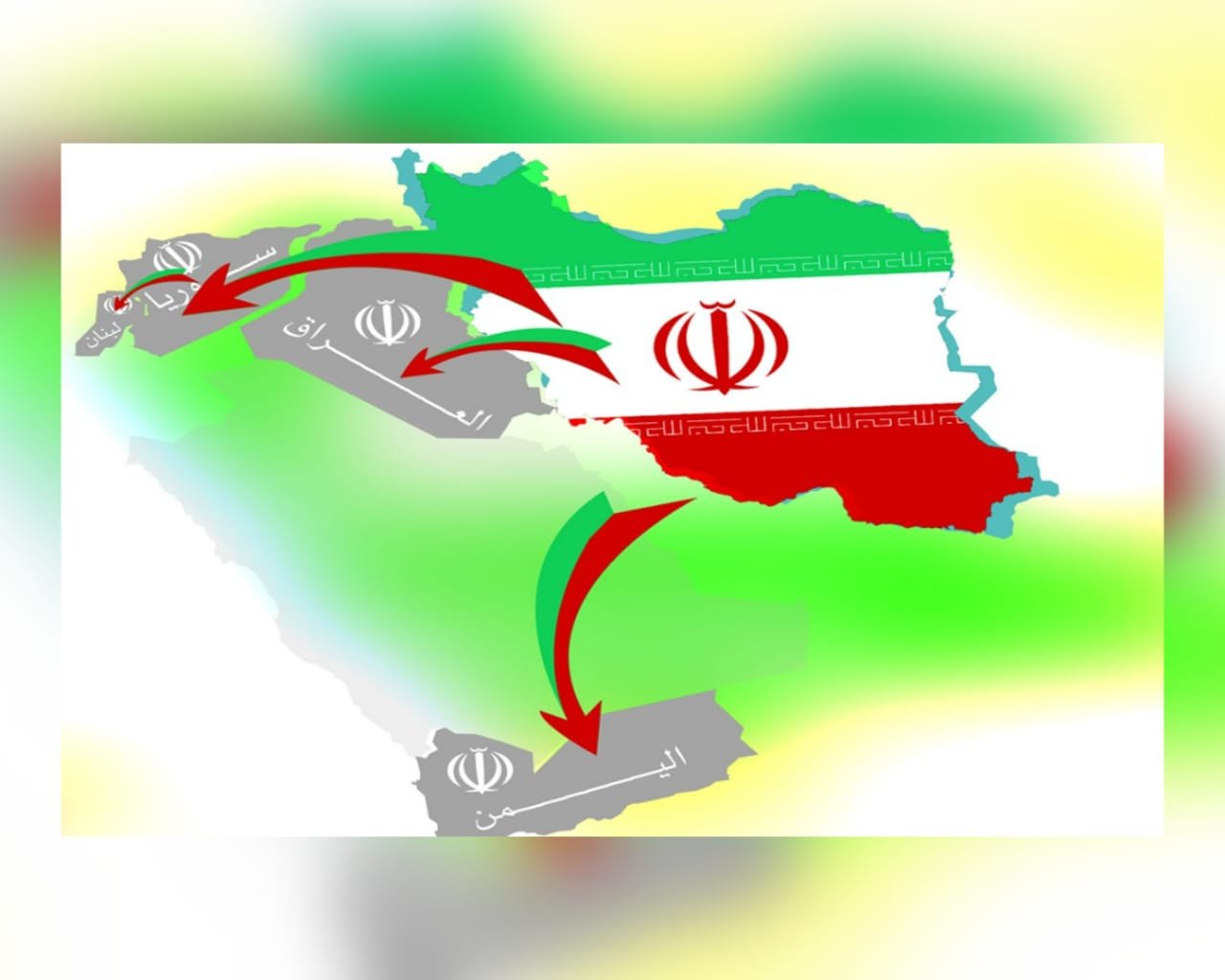قابلتُ الشيخ أحمد الطيب للمرة الأولى بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر في السنة الدراسية 1966-1967. كنا في السنة الأولى بالكلية، وكان هو أعلى منا بسنتين أو بثلاث. لكنه كان يحضر معنا دروس الدكتور محمود زقزوق الذي عاد من ألمانيا بالدكتوراه من جامعة ميونيخ بعملٍ عن الغزالي وديكارت. والشيخ الطيب من أُسرةٍ بالصعيد عُرفت بالانتماء إلى الطريقة الخلوتية الشاذلية، وبالانتساب إلى أشراف آل البيت. والشيخ الطيب كاسمه كان من قلةٍ اهتمّت بنا نحن الطلبة الشوام، كما كان المصريون يسمّوننا. وأكثر الشوام بالكلية كانوا من قطاع غزة وفلسطين والأردن. كنا جميعاً مفتونين بالجديد العلمي والبحثي الذي عاد به زقزوق من ألمانيا. وقد تسمّرنا في مقاعدنا عندما استطرد زقزوق في درسه الثالث أو الرابع في الفلسفة الإسلامية، ليشرح لنا في خُطاطةٍ على السبّورة – اللوح كما يسمّيه المصريون – “أخلاق السلوك” في مدرسة الغزالي الصوفية، مقارنةً بأخلاق العمل لدى الكالفينيين البروتستانت كما شرحها ماكس فيبر.
إقرأ أيضاً: المفتي الشيخ حسن خالد (2/1): الشخصية والرسالة والخير العام
أحمد الطيب الشديد الحبّ لزقزوق كان شديد القلق من المقارنة. لكننا جميعاً كنا نريد أن نعرف أكثر عن البروتستانت، وعن ماكس فيبر. وقد لجأنا إلى الأستاذ بالكلية ( أظنه كان وكيل الكلية) سليمان دنيا، الذي كانت له أعمال عن الغزالي وعن ابن سينا. وما استطاع الرجل إفادتنا بالكثير. إنما الذي هو واثقٌ منه كما قال إنه لاعلاقة للبروتستانت بالتصوف المسيحي لتكون هناك مشابهات مع التصوف الإسلامي، لأن التصوف الوسيط هو تجربة خاصة بالكاثوليك. وبعد شهرين أو ثلاثة، وكنتُ قد وجدتُ عملاً مترجماً لماكس فيبر هو “الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية”، قال لي الشيخ الطيب إنّ المصطلح الأفضل، ومفتاح فلسفة العمل في الإسلام هو “مفهوم الاحتساب”، عندما يعمل المرء الأعمال الصالحة ولا يبتغي من ورائها غير وجه الله، أي أنه يحتسب عمله ليكونَ خالصاً منزَّهاً عن الأغراض الدنيوية.
إنما هل كان الأمر على هذا النحو معروفاً ومتبعاً في العصور الوسيطة لدى الصوفية ولدى غيرهم؟ قال لنا الشيخ عبد الحليم محمود أستاذ التصوّف (والذي صار عميداً لكلية أصول الدين ثم شيخاً للأزهر): لقد كان ذلك واضحاً تماماً. أما قرأتُم عملي عن أستاذ السائرين الحارث بن أسد المحاسبي؟ صحيح أنه لُقّب بذلك لشدة محاسبته لنفسه فكراً وسلوكاً كما ظهر في كتبه، إنما ما هو الفرق أو اللافرق بين المحاسبة والاحتساب؟! ووقتها نشر عبد الحليم محمود رسالةً صغيرةً لأبي سعيد الخرّاز، أحد معاصري المحاسبي، عنوانها “الصدق أو الإخلاص”، وهو المفرد الذي آثره شيخنا عبد الحليم لفلسفة العمل الصوفية والإسلامية. أما الطيب فظلَّ مصراً على الاحتساب، مفهوماً وفلسفةً للعمل في الحياة الدنيا، وفي الاستعداد ليوم المعاد.
ظنَّ الأزهريون، ومعظم الدارسين لتاريخ الأزهر، أنّ القانون رقم 101 للعام 1961 وهو الذي حوَّل الجامع أخيراً إلى جامعةٍ حديثةٍ، هو التطوّر الرئيسي للأزهر في القرن العشرين. وكان المقصود به ترقية التعليم الديني والمدني بالأزهر ودمجهما من جهة، ومواجهة صحويات الإخوان الذين كانوا يحاولون إيجاد بدائل من الأزهر للتثقيف الديني، بعد أن عجزوا عن اختراقه، واعتبروه بيئةً للتقليد الجامد، وللعمل مع السلطان. لكن بعد أربعين عاماً على تلك التطوّرات، وعندما كنت أكتب كتابي بعنوان: “أزمنة التغيير، الدين والدولة والإسلام السياسي” (2012-2013)، أدركتُ أن التحوّل الحقيقي في مسيرة الأزهر كان يحدث فيما بين الستينات والسبعينات عندما اشتدّ الصراع الأيديولوجي على التقليد والموروث. الحداثيون العرب رأوا ضرورة إزالة الموروث (الديني) باعتباره أصل الأزمة الحضارية، والعقبة الكأداء أمام التقدّم (صادق جلال العظم 1968، ومؤتمر الكويت 1974). وأستاذ مادة التوحيد (علم الكلام) بالأزهر، وكان للمرة الأولى سلفياً أراد استبدال كتاب “الإيمان” لابن تيمية بكتاب “المواقف” لعضد الدين الإيجي وهو ركن التقليد الأشعري في الاعتقاد. وأستاذ الفقه والأصول ترك النصوص القديمة ووزّع علينا “ملازم”، كما كانوا يسمونها، في فقه الأَولويات الذي كان الصحويون يريدون التجديد الفقهي من خلاله. وما تنبَّه أحدٌ للتغيير المؤقت في مقرّر علم الكلام، في حين استبدلت إدارة الكلية بالأستاذ الصحوي الشيخ محمد أبو زهرة (وكان قد تقاعد من جامعة القاهرة) فقرّر علينا كتابه في أصول الفقه، وسخر في درسه الأول من خزعبلات الأولويات. وهكذا فقد كان البحث في ” تجديد التقليد” أو من خلاله، ومن طريق مفاهيم تأويلية تقع بين مقاصد الشريعة، وفلسفة الاحتساب، هو السبيل لفك الحصار والتطويق من جانب أهل الإنكار وأهل الغلوّ على حدٍّ سواء.
هل كان ذلك كله واضحاً في أذهان كهول الأزهر؟
هذا ما ذهب إلى “وضوحه” في الأذهان آنذاك، وإن أخبرني به في تسعينات القرن العشرين أستاذنا محمد عبد الفضيل القوصي الذي صار وزيراً للأوقاف بعد ثورة العام 2011 لفترة قصيرة، وكان في أواخر الستينات معيداً بكلية أصول الدين، ومن أنصار الأشعرية المتحمّسين.
جيل زقزوق والقوصي والطيب، هو جيل التحوّل في الأزهر باتجاه هويةٍ أزهريةٍ متميّزة هي في نظرهم “الاعتدال الإسلامي” ذاته. وصحيح أنهم ظلوا مهجوسين بالعلمانية وشرورها والاستشراق واستعمارياته، لكنهم جميعاً تقريباً امتلكوا تجربةً غربيةً في دراساتهم العليا.
شيخنا عبد الحليم محمود هو تلميذٌ قديمٌ لماسينيون بالسوربون، وقد ذهب مثل محمد عبدالله دراز (فخر الأزهريين العلمي والتأويلي بعد محمد عبده) باللباس المدني، وعاد بالعمامة والجبّة والتصوّف. وعلى منواله نسج الشيخ الطيب الذي قضى في السوربون عدة أعوام، في حين أثر في قسمٍ من جيلنا محمود زقزوق وأستاذه محمد البهي فذهبنا إلى ألمانيا. ولا أدري إن كان مقصوداً أو مصادفة أن يتولى مشيخة الأزهر ووزارة الأوقاف في عهدي السادات ومبارك شخصيات معظمها من كلية أصول الدين. وإلى جانب بروزه في التدريس بكلية أصول الدين وشعبيته بين الطلاب والأساتذة، عُرف عن الشيخ الطيب قربه الدائم من أستاذنا زقزوق الذي تولى وزارة الأوقاف لعقد ونصف، ومن شيخَي الأزهر جاد الحق وطنطاوي. وليس بحكم السنّ فقط، بل وبسبب الوعي بالتحدّيات برزت في هذا الجيل بالفعل خلال عقدي الثمانينات والتسعينات سياساتٌ للدين تمايزت عن الصحويين وعن السلفيين المصريين، وأكثر عن الحداثيين المصريين.
وقد ذكر لي الوزير زقزوق مرة عام 2008 أو 2009، وكنت أسأله عن خلفيات نزاعٍ ظهر في الصحف بين الشيخ الطيب (وكان ما يزال رئيساً لجامعة الأزهر) وبعض المثقفين والإعلاميين المصريين، فقال لي إنّ الشيخ الطيب تدخَّل دفاعاً عن شيخ الأزهر طنطاوي: “ولسوء الحظ علاقات الأزهر سيئة مع المثقفين والإعلاميين. فنحن نقرأُ لهم أمّا هم فلا يقرأون لنا، وهم يعاملوننا كأننا جماعة كهنوتية تعيش في كهوف الماضي، بينما يمرّ في مؤسساتنا التعليمية حوالى ربع فتيان وشباب مصر، ولدينا نحن في وزارة الأوقاف مائة ألف إمام بمصر وبالخارج، وفي الأزهر نصف مليون طالب وأستاذ وإداري فضلاً عن عشرات الفروع بسائر أنحاء العالم الإسلامي. هي مسؤولياتٌ هائلةٌ، وطبيعي أن تقع أخطاء وتفويتات. لكننا منخرطون في حركة تغيير كبير بالمشيخة وبالجامعة وبوزارة الأوقاف وبدار الإفتاء. ونحن في سباقٍ مع التطوّرات الداخلية والخارجية بسبب مسؤوليتنا عن الإسلام بمصر ومع العالم، والله يستر، فحبّذا لو يكون المثقفون والإعلاميون معنا، وهذا رأي الشيخ الطيب أيضاً، لكنهم في الحقيقة ليسوا كذلك!”.
بعد تدريسٍ بالخارج، ومناصب إدارية بالأزهر، تولى الشيخ أحمد الطيب منصب مفتي مصر لفترةٍ قصيرةٍ، ثم صار رئيساً لجامعة الأزهر لثماني سنوات، فشيخاً للأزهر منذ العام 2010. وفي الجامعة والمشيخة ظهرت نتائج تجربته الطويلة، وقدراته على التطوير والانفتاح والمحافظة الواعية في الوقت نفسه. لكنّ أبرز ما واجهه: تحدي الانشقاق العنيف في الدين، وتصحيح العلاقة مع العالم.
الشيخ الطيب كان شديد الخوف على العقيدة التقليدية لأهل السنة، لما شهده من تشهيرٍ بها في الأوساط الأكاديمية، ولما رآه بين الطلاب من انصرافٍ عنها إلى السلفيات والصحويات الإخوانية والعلمانية
عندما قابلتُه بعد توليه منصب رئيس جامعة الأزهر ذكّرني بـ”الاحتساب” الذي كنا نتجادلُ حوله مع الدكتور زقزوق (الذي توفّي قبل شهرين عن عمرٍ عالٍ) أواخر الستينات. قال إنّ جامعة الأزهر هائلة الضخامة، ورغم تقسيمها إدارياً ما تزال تحتاج إلى كلّ شيء. وأكبر الاحتياجات في الكليات والجهات الإسلامية: أصول الدين، والشريعة، واللغة العربية، وكلية اللغات. قال إنّ الإمكانيات والطاقات كبيرة إنما هناك حاجة ملحة لثلاثة أمور يحدوها مبدأ عقدي. والأمور الثلاثة هي: التطوير الدائم للمناهج في الجامعة وفي المعاهد، والدأب على إرسال البعثات للخارج، والاهتمام الفائق بالبحث العلمي في الدراسات العليا. أما المبدأ الاعتقادي الدافع في الأمور الثلاثة فهو: “الاحتساب” الذي ينبغي أن يتربّى الجميع عليه. لماذا نكون أقل من اليسوعيين؟ فحتى كلية طب الأزهر، ينبغي أن تكون متميّزةً على سائر كليات الطب بالبلاد، باعتبار أنه ينبغي أن يكون الاحتساب هو روح العمل. وهناك إجماعٌ بين العارفين بالحياة الجامعية المصرية أن “حقبة” أحمد الطيب في رئاسة جامعة الأزهر، كانت حقبةً زاهرة ونهضوية، وشديدة الانضباط، وتكاد تخلو من الفساد، لكنه كان قاسياً بعض الشيء مع الأساتذة، ولا يحب الاتجاهات الحزبية بين الطلاب، مع غرامٍ شديدٍ بالأساتذة المتميّزين، والطلاب الموهوبين.
وقد بقي أمرٌ مهمٌّ ينبغي ذكره عن حقبة ولاية الشيخ الطيب لرئاسة جامعة الأزهر، وهو أنه عقد مؤتمراً ضخماً دعا إليه مئات من العالم الإسلامي السني بعنوان: “أبو الحسن الأشعري والأشعرية في القديم والحديث”. والأشعرية هي المدرسة العقدية التاريخية الرئيسية عند أهل السنة. وقد قال السبكي في القرن الثامن الهجري إنّ أهل السنة والجماعة هم أتباع المذاهب الفقهية، والحنابلة وأهل الحديث، والصوفية. وقد تعرّضت الأشعرية في القرن العشرين لضغوطٍ هائلةٍ من المستشرقين والحداثيين والسلفيين الجدد.. والصحويين. وفي حين جرى اجتهادٌ فقهيٌّ كبير، ما كان هناك تجديد معتبر في عقديات الأشعرية ولا في دراساتها، رغم الدعوات لعلم الكلام الجديد (شبلي النعماني، 1902، ورسالة التوحيد لمحمد عبده). بل إنّ النهضويين وفي موازاة حملتهم على جمود الأشعرية ورجعيتها، كانوا يضعون آمالهم في الحركات الإسلامية الجديدة. ومع أنّ الأزهر هو بيئة التقليد السني العقدي والفقهي، فإنّ بعض شيوخه في الأربعينات وما بعد ما عادوا ينتسبون علناً لأحد المذاهب الفقهية السنية أو العقيدة الأشعرية. وعندما كنا بالأزهر (1965-1970) ما كان أحدٌ من الشيوخ الكبار أو أساتذة الجامعات، يبحث في الأشعرية غير الدكتور علي سامي النشار.
المهم أنّ الشيخ الطيب كان شديد الخوف على العقيدة التقليدية لأهل السنة، لما شهده من تشهيرٍ بها في الأوساط الأكاديمية، ولما رآه بين الطلاب من انصرافٍ عنها إلى السلفيات والصحويات الإخوانية والعلمانية. كان كثيرون من أساتذة الجامعات، والشبان المدرّسين، يعتبرون أنفسهم معتزلةً جدداً أو رشديين. وقد قال لنا الدكتور الطيب عندما وصلنا للمؤتمر: أنا لا أخشى على عقائد الجمهور المصري أو العربي الإسلامي، لأن المتديّنين منهم يتربّون غالباً في المساجد وجمعيات قراءة القرآن والرمضانيات. لكنّ مجموعات كبيرة من الطلاب وشباب الأساتذة يتجهون تحت تأثيرات الظروف نحو اللاّدين أو التطرّف الديني. ولذلك ينبغي التفكير والعمل على التجدّد العقدي كما جرى العمل على التجديد الفقهي. وقد تبين من المؤتمر أنّ للأشعرية (إذا قُرنت بالماتريدية الشبيهة لدى أتباع المذهب الحنفي) بقيةً معتبرة بين الشيوخ الكبار في آسيا وإفريقيا، إنما لا يمكن الحديث عن نهوضٍ بحثي أو تجديدي فيها.
وما سُرَّ الشيخ من دعوتي في بحثي بالمؤتمر إلى التقارب والمصالحة بين التيارات العقدية لدى أهل السنة تحت راية الأشعرية، وقد كانت تحتضن الجميع قديماً، وتعتبرهم سنيين بدون عنفٍ أو استبعادٍ أو تكفير. قال لي: لكنّ هؤلاء الذين تدعو لمصالحتهم هم الذين يكفّرون ويمارسون العنف، ويريدون الصراع بين الدين والدولة الوطنية بحجج الجاهلية والحاكمية كما تعرف ونعرف!