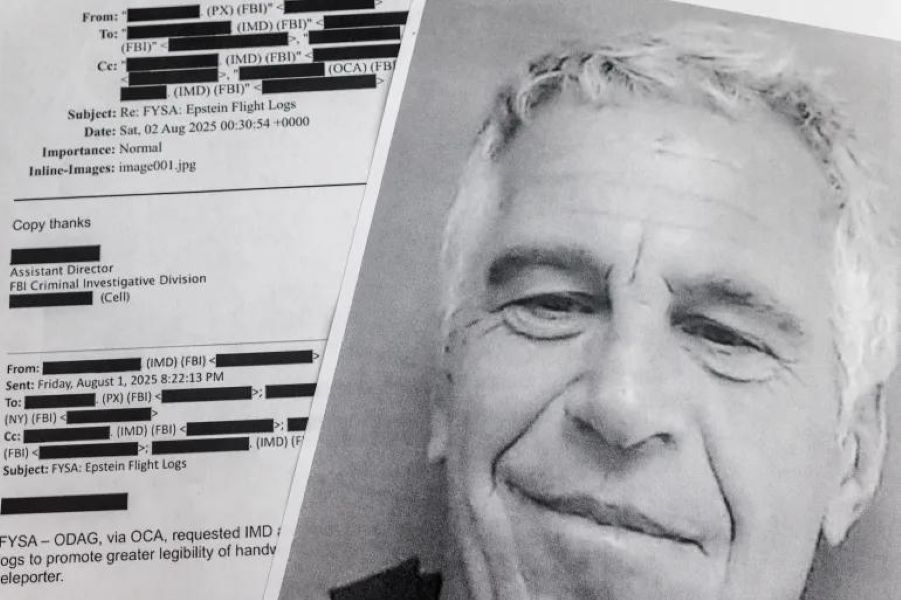مع إغتيال بشير الجميّل في الرابع عشر من أيلول 1982، لم يُكتب “النصر الحاسم” لأي من المعسكرين الغربي والشرقي وتوابعهما اللبنانية. كان ثمة خياران أمام البلد عبَر عنهما وصول أمين الجميل إلى رئاسة الجمهورية. الخياران توزعا بين إصلاء إسرائيل حرب تحرير لا هوادة فيها والإنحياز إلى دمشق، أو الإستسلام لـ”إتفاقية سلام” مع الدولة العبرية إسمها “17 أيار”. أمين الجميّل لم يفعل أياً من الأمرين. صعد إلى بعبدا وترك تحديد الوجهة للفريقين المحليين المتصارعين. الأول هُزم عملياً بإغتيال رئيسه. الثاني راح يصعد بسرعة مُستفيداً من “شيعية سياسية” إنضمت إليه بعدما تعسكرت حتى النخاع مع الإمام السيد موسى الصدر ثم مع الثورة الإيرانية.
ولئن صاغ الفريق الثاني سرديته السياسية وسيرته العسكرية تحت عباءة “تحرير الأرض”. فقد عَمِل على إستئناف ما بدأه اليسار اللبناني لجهة إصلاح النظام السياسي. وقد تولى إسقاط “إتفاق 17 أيار” و”مهمة التحرير”، فيما راح الجميّل يغازل واشنطن ودمشق في آن ليكون علامة جمع للإثنين في لبنان. خلاصة مذكراته الأخيرة لا تفيد بغير ذلك. فقد تولت صوغ جملة سياسية واحدة وموجهة للموارنة ومفادها: كابدت ما كابدت ولم أتنازل عن الصلاحيات، التي كانت عملياً إمتيازاً لـ”المارونية السياسية” أكثر من كونها ضمانة لبنانية عامة تراعي التنوع الهوياتي الذي يُغرِق لبنان. ما يستدعي التنبه إليه هو رعاية الجميّل لإسقاط “الإتفاق الثلاثي” بما شكل من حظوظ تسوية إصلاحية تعيد تنسيب لبنان إلى العالم العربي وتحسم في وجهة الحرب مع إسرائيل.
مأساوية إغتيال الرئيس الحريري أضاف إلى النكبات اللبنانية المتتابعة أهوالاً رهيبة تمثلت بحلول “حزب الله” محل حليفه الأسدي في الإمساك بأعنة السلطة ترهيباً وترغيباً
إذا صح أن أمين الجميّل رعى توازناً خارجياً في البلد، فهو لم ينجح في تأمين إجراء إنتخابات رئاسية كان الجميع لا يريدها آنذاك، ما سبب خراباً عميماً مضافاً على توليّة قائد الجيش حينها ميشال عون مقاليد السلطة السياسية والعسكرية من طريق “الحكومة العسكرية”. فكان أن حل الفراغ الرئاسي. ولحقته حروب إنفجار الكانتونات الطائفية على بعضها البعض فكانت “حرب الإلغاء عند المسيحيين، و”حرب الإخوة” عند الشيعة فيما السُنة كانوا خلواً من أية أنياب عسكرية بعد تصفية ذراعهم العسكرية ولو شكلياً أي حركة “المرابطون”. صاحب ذلك ورافقه عودة بمعنى ما إلى لحظة العام 1988 حيث شن عون ما سُميَ “حرب التحرير” في وجه سوريا التي إستدعي “عراق صدام حسين” لمؤازرتها ونصرتها بالمال والعتاد. آنذاك بلغ الإنهاك حد إنعدام أي أُفق سياسي.
أولى الأزمات وتصدع الجمهورية
هذه كانت أوّل أزمة فراغ رئاسي في لبنان، وأعلنت بوضوح قاطع أن النظام السياسي تعطل وصار خارج الخدمة. على هذه الوقائع المحطمة إنتهز العرب وبقرار دولي اللحظة السياسية للإستثمار في بناء سلم سياسي يحقق للجميع ما يرمونه. فكان إتفاق الطائف الذي قدم أمرين متلازمين، وهما نهائية الكيان اللبناني، بما هي مطلب تاريخي للمسيحيين اللبنانيين، وعروبة لبنان التي كانت مطلباً تاريخياً أيضاً للمسلمين اللبنانيين. وبذلك فإنّ هذه المقدمّة تكون قد ربطت بإحكام بين ثلاثة أركان جوهرية للوطنية اللبنانية هي: نهائية الكيان، وعروبة لبنان، وميثاق العيش المشترك.
تحت ظلال الرعاية العربية أُقرت “وثيقة الوفاق الوطني” التي عُرفت إصطلاحاً “إتفاق الطائف”، وبموجبها إنتُخب رينيه معوض عاكساً ميزان قوى لم تكن الأرجحية فيه لسوريا بل تطلُب تنظيم خروج قواته العسكرية والإستخبارية التي أقامت ردحاً طاول حينها الـ 15 عاماً. تم الاتفاق برعاية مصرية ـ سعودية تؤازرها مظلة دولية في الأمم المتحدة. هذا التوازن ـ الميزان عكس إختلالاً عبر عنه اغتيال معوَض مع عودة سورية من باب تفويض دولي تحصلت عليه من كارثة إحتلال الكويت عام 1990.
إغتيال معوَض وإنتخاب الياس الهراوي خلفاً له شكل إعلاناً صريحاً بتسيد النظام السوري على لبنان “الخاصرة الرخوة” له. تكرس ذلك بموافقتين عربية ودولية. وقد بلغ إنهاك القوى المسلحة حد تسليم سلاحها.
التسيُد السوري وبالتوازي مع تفويض “حزب الله” مهام “تحرير الأرض من الإحتلال الإسرائيلي”، كان يجاهر بوقائع الطوائف وحظوظها من تشكُل لبنان. فإذا كان الموارنة هم صناع “لبنان الكبير” وعنوان الحداثة وبوابة لبنان على الغرب، فيما السُنة شركاء أصليين في الوطن الوليد وانتزعوا إستقلاله من الفرنسيين عبر عونٍ بريطاني ومدد مصري شكله “النحاس باشا” المقيم في ظلال الإنتداب الإنكليزي، فإن الشيعة ومتأخرين جاؤوا ليقرروا الدور الحاسم في “جيوبولتيك” لبنان الجديد.
أحسن جيداً “حزب الله” إستخدام “فيتو التعطيل” الذي ناله من إتفاق الدوحة فحاز “الثلث المعطل” الذي إستخدمه خلال ولاية ميشال سليمان، دافعاً إياه في اتجاه فرض الرئيس الذي يريد
أهوال سوريا وإسرائيل على البلد
هذا ما حصل بالتمام والكمال على إمتداد ثمانينيات القرن الماضي حتى العقد الثاني من القرن الحالي. فكان تحرير لبنان من الإحتلال الإسرائيلي جنوباً، وصولاً إلى خوض ما أسماه “الحزب الإلهي” بـ”التحرير الثاني”من تنظيمات “داعش” الإرهابية شرقاً عند الحدود مع سوريا. أكلاف ذلك على البلد وعلى الدستور والعيش المشترك كانت باهظة جداً، إذ صارت هذه المنظمة الأمنية العسكرية مالكةٌ لقراري الحرب والسلم، وكذلك توليد حكومات وشق الطريق لرئاسة الجمهورية التي تتوجت بتولية ميشال عون “قائد الطريق” إلى جهنم التي لا نني نسقط فيها ولم نبلغ دركها الأسفل بعد.
إحكام سوريا قبضتها على لبنان جاء بكلفة عالية. هذا الإمساك بالبلد راح يصفع “الديموقراطية اللبنانية” حيناً باستعادة أهوال الحرب الأهلية، وأحياناً بإدعاءات قومية ومزاعم تحريرية. شدة تأثر لبنان بخارج ما تحضر بقوة أنى كانت وجهة الأحداث الإقليمية والدولية.
مأساوية إغتيال الرئيس الحريري أضاف إلى النكبات اللبنانية المتتابعة أهوالاً رهيبة تمثلت بحلول “حزب الله” محل حليفه الأسدي في الإمساك بأعنة السلطة ترهيباً وترغيباً.
الوصاية السورية على البلد بصفتها ومسمياتها الكثيرة راحت تصنع الرؤساء في زمن السلم الأهلي الذي بقي بارداً بعد إقرار وثيقة الوفاق الوطني. ولم ينجح اللبنانيون في جعل سلمِهم حاراً. أيضاً وأيضاً لإنهماكهم على جاري عادتهم بإستدعاء الإنتباه الخارجي وتقديمه على الداخل وقضاياه. هكذا جاء إنتخاب الهراوي فالتمديد له، قبل أن يخلفه إميل لحود ولايةً وتمديداً أيضاً عام 2004 في لحظة اشتباك أميركي – سوري إنتهى إلى خروج الأخير من لبنان.
في السياق هذا، لا يحضر إلا الماضي المظلم، حيث سيطرت حلقة محكمة من الإغتيالات لمعادي “الوجود السوري” الذي قُونن بمقولة “ضروري وشرعي وموقت”. تلاها “حرب تموز” عام 2006 التي بقيت نتائجها ملتبسة على قوى “8 آذار”. فكان الحل باللجوء إلى تكثيف التعطيل بما في ذلك انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وصولاً إلى اتفاق الدوحة الذي وضع حداً شكلياً لهذا التعطيل. وبتأثير الخارج مجدداً وأيضاً تم التوافق على انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية وكـ”مكافأة” له على “حياده” في غزوة “7 أيار”.
أحسن جيداً “حزب الله” إستخدام “فيتو التعطيل” الذي ناله من إتفاق الدوحة فحاز “الثلث المعطل” الذي إستخدمه خلال ولاية ميشال سليمان، دافعاً إياه في اتجاه فرض الرئيس الذي يريد. وهو ما تحقّق له بإيصال ميشال عون إلى سدّة الرئاسة عام 2016، بعد فراغٍ دام سنتين ونصف. طبعاً، لم يكن لـ”حزب الله”أن يبلغ ما وصله بمعزل عن “الربيع العربي” الذي كان من أسوأ نتائجه إنشغال الدول العربية، وبالتالي إنكفاؤها عن لبنان. ترافق هذا، مع صعود إيراني أهمه كان في الإتفاق النووي عام 2015، وشبه إبتعاد أميركي عن المنطقة ككل مع الرئيس باراك أوباما الذي إستدار نحو الإهتمام بالقوة الإقتصادية الصينية بغرض إحتوائها.
إقرأ أيضاً: انتخابات الرئاسة اللبنانيّة.. الخارج مُتحكِّم دوماً (1)
الآن، لبنان على أبواب إنتخابات رئاسية. وكائناً من كان الرئيس فأيٌ من الأرجحيتين سيحمله إلى بعبدا؟. طبعاً، فإن أحداً لا يتوهم حصول إنتخابات لبنانية تأتي خلواً من أوزان الخارج وهو أميركي ـ عربي (سعودي) ـ أوروبي ـ إيراني فللجميع “كوتا” في لبنان.