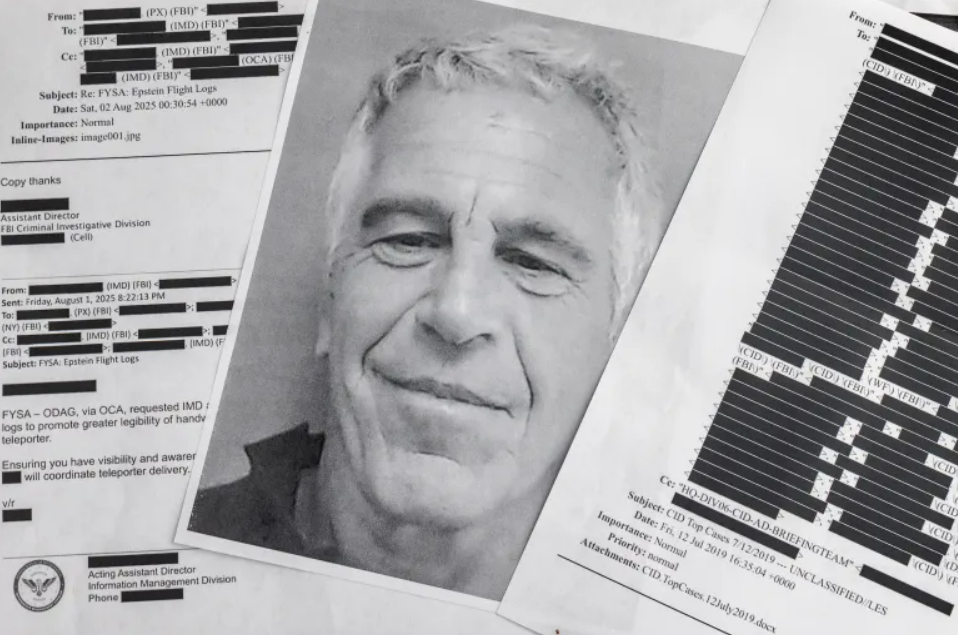ليل 14 تمّوز عام 1789، دخل الدوق فرانسوا ألكسندر فريديريك على الملك لويس السادس عشر، وأبلغه بسقوط “الباستيل”. فقال الملك: “هذا تمرّد كبير”. أجابه الدوق: “كلّا سيّدي. إنّها ثورة كبيرة”. وهكذا دخلت كلمة ثورة في القاموس السياسي في فرنسا والعالم. وأصبحت ساحة “الباستيل” رمزاً للثورة الفرنسية. منها تنطلق التظاهرات الاحتجاجيّة على تنوّع مطالبها.
بعد الثورة الفرنسية عرفت أوروبا موجة من الثورات في عام 1848 لدوافع اقتصادية واجتماعية. سقطت إمبراطوريّات وقامت جمهوريّات. فيما بعد قامت ثورات تحرّريّة عديدة ضدّ الاستعمار. نجحت في الحصول على الاستقلال بعد صراعات دمويّة. في عام 1917، أنهت الثورة البولشفية حكم القياصرة في روسيا، وأسّست الجمهورية الاشتراكية السوفياتية. كلّ هذه الثورات كانت دمويّة. لذلك تتّفق غالبيّة التعريفات اللغوية والفلسفية والتاريخية لكلمة ثورة على أنّها حركة نجحت بسرعة وباستعمال العنف في قلب النظام القائم وفي تأسيس نظام جديد.
ما حدث في 17 تشرين الأول عام 2019 لا يرقى إلى مستوى الثورة لأنّ الجماعات التي نزلت إلى الشارع لم تتمكّن من إسقاط السلطة القائمة. فهو أقرب إلى التمرّد كونه حركة اعتراضية
إذاً ما حدث في 17 تشرين الأول عام 2019 لا يرقى إلى مستوى الثورة لأنّ الجماعات التي نزلت إلى الشارع لم تتمكّن من إسقاط السلطة القائمة. فهو أقرب إلى التمرّد كونه حركة اعتراضية انطلقت في الشارع محاوِلةً إسقاط السلطة القائمة. ولكن حتى هذه التسمية لم تعد تنطبق عليه بعد توقّف الحركة الاعتراضية. لذلك نسمّيه “حراكاً”، وبحذر. فها هي الذكرى الثانية لـ17 تشرين تحلّ من دون الإعلان عن أيّ تحرّك في الشارع على الرغم من أنّنا دخلنا “رسميّاً” في “جهنّم” منذ أيلول الفائت. فقضية التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت في وضع مأزوم. والطبقة السياسية، التي أوصلت البلاد إلى الانهيار، لا تزال في السلطة، وقد أعادت تنظيم صفوفها في حكومة نجيب ميقاتي. وهي الآن تستعدّ لخوض الانتخابات النيابية لإعادة تأكيد شرعيّتها الشعبية والعودة أقوى إلى السلطة.
تراجُع الحراك وضعفه لهما أسبابهما التي نختصرها بالآتي:
1- بدأ الحراك عفويّاً في 17 تشرين الأول عام 2019. وهذا طبيعيّ. لكنّه استمرّ نوعاً ما عفويّاً. التجمّعات، التي نشأت إثر انطلاق الاحتجاجات، وتلك التي كانت موجودة، نجحت لفترة في التنسيق فيما بينها من أجل تنظيم الاعتصامات والتظاهرات. ولكنّها لم تتوصّل إلى وضع إطار تنظيميّ صلب وجامع يحفظ استمراريّة حراكها.
2- تعدّد الاعتصامات من الشمال إلى الجنوب، ومن البقاع إلى الساحل، أدّى إلى تبدّد قوّة الشارع وزخمه. في الأيام الأولى كان من الطبيعيّ أن يكون الحراك في بيروت وطرابلس وصيدا وجونيه وجل الديب، لكن فيما بعد كان على الناشطين الاتفاق على تركيزه في العاصمة بيروت. إنّها المركز (بالمعنى الجيوسياسي) في الدولة. هنا مركز السلطات التشريعية والإجرائية والقضائية. وهنا تتركّز الوزارات والإدارات العامّة. والضغط لإسقاط النظام أو الطبقة السياسية يجب أن يكون هنا.
3- لم يفرز الحراك شخصيّات قياديّة قادرة على استقطاب الجماهير حول خطاب واحد ومشروع واحد. المثقّفون والأكاديميّون والكوادر المتنوّعة على أهميّة وجودهم لا يمكنهم أن يقودوا حراكاً شعبيّاً، وأن ينظّموا تظاهرات واعتصامات. وللمناسبة، هذا ما افتقرت إليه أيضاً المعارضة السورية، وكان أحد أسباب فشلها.
4- تمسّك الكثير من الناشطين بأيديولوجيّاتهم السابقة. الحراك، الذي امتدّ في بداياته على مساحة الوطن، ضمّ ناشطين من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. لم يستطع هؤلاء التحرّر من أيديولوجيّاتهم المتناقضة للاتّفاق على شعارات موحّدة في الشارع الواحد والساحة الواحدة. فكانت أصوات تصرخ ضدّ “حزب المصرف”، وأخرى ضدّ حزب الله، وأخرى ضدّ الإمبريالية، وأخرى ضدّ الصهيونية. وهذا ما انعكس سلباً على أداء الحراك وخطواته.
الحراك، الذي امتدّ في بداياته على مساحة الوطن، ضمّ ناشطين من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. لم يستطع هؤلاء التحرّر من أيديولوجيّاتهم المتناقضة للاتّفاق على شعارات موحّدة في الشارع الواحد والساحة الواحدة
5- لم يتحرّر أيضاً العديد منهم من الانتماء الحزبي ومن الولاء لزعيم الحزب من أجل تأسيس حالة سياسية جديدة. فكانوا ينتفضون عند كلّ صرخة ضدّ زعيمهم الفاسد. وهذا ما جعل الشارع ينقسم إلى شوارع، حتى في الساحة الواحدة. كلّ منهم يصرخ ضدّ فساد زعيم الشارع الآخر. كانت الحالة الطائفية حاضرة أيضاً وبقوّة على الرغم من الكلام الكثير عن تخطّيها لمصلحة الانتماء إلى الوطن، خاصة أنّ زعماء الأحزاب على مدى ثلاثة عقود حوّلوا الأحزاب إلى عشائر طائفية يخاف بعضها بعضاً، فأصبحت الحالة الطائفية بعد الحرب حالة غير مسبوقة في تاريخ لبنان.
6- رفض النقابات الانضمام إلى الحراك. في الديموقراطيّات، تقود النقابات الشارع في حركاته الاحتجاجية المطلبية. في الديموقراطية اللبنانية “المضروبة”، وقفت النقابات في صفّ الطبقة الحاكمة. بعضها عمل ضدّ الحراك. والسبب أنّ المنظومة الحاكمة، خلال ثلاثة عقود، أحكمت قبضتها على كلّ المجالس النقابية. فرئيس الاتحاد العمّاليّ العامّ، مثلاً، يتحرّك غبّ طلب رئيس المجلس النيابي. أمّا باقي النقابات والرابطات فتتقاسم الأحزاب مجالسها التنفيذية. لذلك لم يشارك أيٌّ منها في الحراك، إلا أنّ العديد من كوادرها كانوا ناشطين في الساحات.
7- نجاح الأجهزة الأمنيّة، بأمر من المنظومة الحاكمة، وتحديداً حزب الله، في قمع الحراك بالقوّة. في البداية أرسلت الأجهزة عناصر اندسّت بين المتظاهرين. اعتدت على الأملاك الخاصّة والعامّة، ورمت الحجارة والقنابل الحارقة على القوى الأمنيّة لتبرير استعمال هذه الأخيرة العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميّين. فيما بعد عملت الأجهزة الأمنيّة على تقييد حركة الناشطين على الأرض من خلال استدعائهم وتوقيفهم وإرغامهم على التعهّد خطّيّاً بعدم القيام بأيّ نشاط سياسي. وقد برزت هذه السياسة الأمنيّة للحكومة بعد تسلّم محمد فهمي وزارة الداخلية. فهو خرّيج مدرسة الجهاز الأمنيّ اللبناني – السوري. ويُتقِن أساليب القمع وكمّ الأفواه.
8- تهديدات الأمين العامّ لحزب الله للمعتصمين ولقاطعي الطرقات، التي تجسّدت بإغارات عناصر حزب الله ومناصري حركة أمل المتكرّرة على المعتصمين في وسط بيروت. فكانوا في كلّ مرّة يحرقون خيمهم ويعتدون عليهم بالضرب. ولم يسلم من ضربات عصيّهم ضبّاط وعناصر قوى الأمن المولَجة حماية الاعتصام السلميّ.
إقرأ أيضاً: الديموقراطيّة والانتخابات: لا تعايش مع سلاح الحزب
نرى اليوم العديد من ناشطي الحراك يسعون إلى تأسيس جمعيّاتٍ وتياراتٍ وأحزاب. يستعدّون لخوض الانتخابات النيابية المقبلة منفردين. ينسّق بعضهم فيما بينهم لتشكيل لوائح مشتركة. لكنّ كلّهم يرفضون التنسيق أو التحالف مع أيٍّ من الأحزاب أو الشخصيّات السياسية التي لم تشارك في الفساد، لا بل تحاربه منذ ما قبل 17 تشرين، والتي شكّلت رافعة سياسية وشعبية للحراك. لذلك تبدو حظوظهم ضئيلة في الوصول إلى البرلمان بكتلة نيابية وازنة. مشكلتهم في ذلك أنّهم أضحوا أسرى شعار: “كلّن يعني كلّن”.
* أستاذ في الجامعة اللبنانيّة