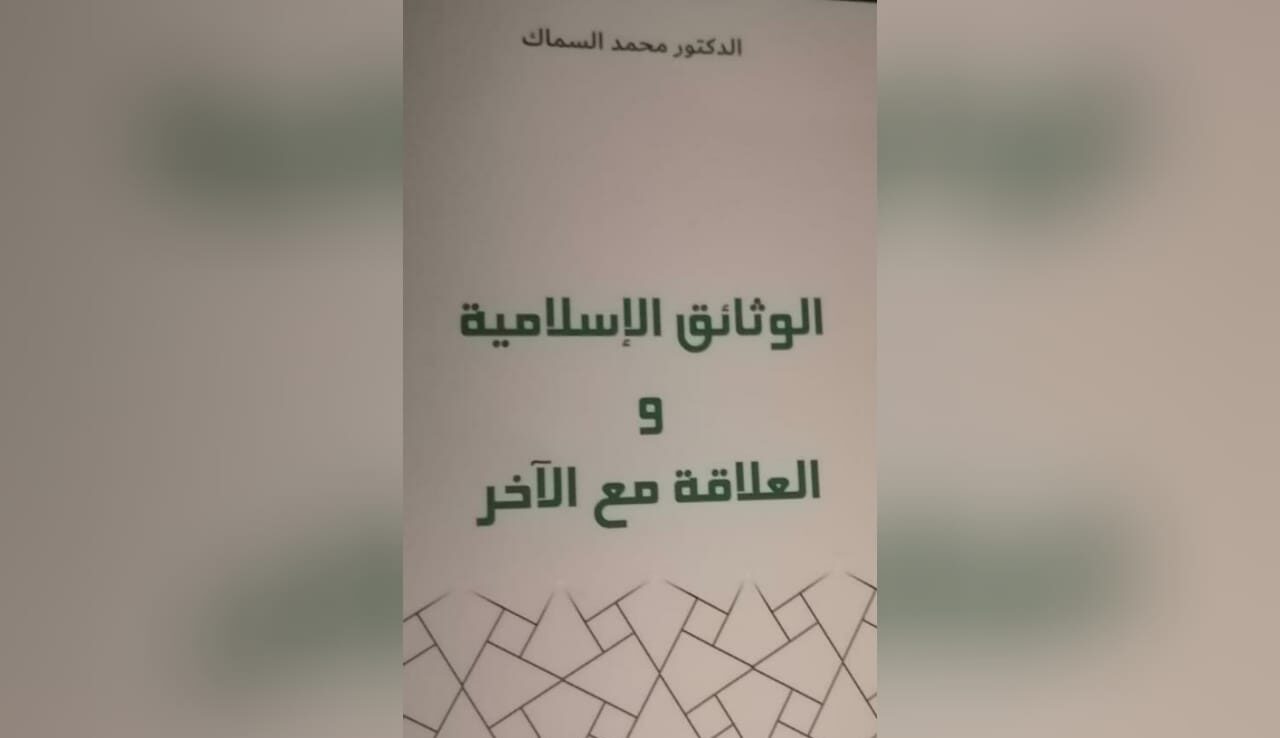يُمكن اعتبار الكتاب الجديد للكاتب والصحافي محمد السمّاك: “الوثائق الإسلامية والعلاقة مع الآخر” الصادر أخيراً عن دار المقاصد للتأليف والنشر، خلاصة مكثّفة لتجربة طويلة وغنيّة خاضها المؤلّف في مجال حوار الأديان، حتى بات عَلَماً في هذا المجال، اختُصّ به، كما عُرف به. وبسبب هذه التجربة الطويلة والاحتكاكات المستمرّة مع ممثّلي الأديان، لا سيما في العلاقة مع الفاتيكان، وردت له نظراتٌ في الفكر الإسلامي، يرى أنّها ضرورية لتجديد فهم الإسلام، وليس تجديد الإسلام نفسه.
تجديد الفهم في الإسلام أمر مشروع ومطلوب مع تغيّر الواقع وظهور الجديد باستمرار وعلى نحوٍ متسارع، لا سيما في الأزمان الحديثة، علماً أنّ تجديد الأفهام بالإسلام لم يتوقّف إطلاقاً، لا في زمن نهضة ولا وقت نكسة، وكان الفقهاء في كلّ أزْمة أو وَكْسة يتصدّون للنوازل، وهي الحوادث الطارئة التي لم يسبق أن مرّ بها المسلمون من قبل، وتتطلّب تدخّلاً من العلماء بحثاً عن أجوبة. وأكثر ما ينبغي الاجتهاد فيه اليوم، في زمن غلبة الغرب العلماني في توجّهاته، وإن كان يستند إلى الإرث المسيحي اليهودي المشترك، وضع تصوّر حضاري لدور الإسلام في العالم، وصياغة طرائق العلاقة مع الآخر، في الدولة الوطنية المتعدّدة الأعراق والأديان، في العالم الإسلامي، وكيفية التعامل مع شركاء الوطن الواحد، أو في الدول الأخرى، غرباً وشرقاً، وفيها أقلّيات وجاليات إسلامية تُعدّ أحياناً بالملايين. وكلّ هذا في عالم مترابط الأوصال، خاضع لقوانين ونُظُم موحّدة، والمصالح الاقتصادية الحيوية المشتركة تخترق كلّ الهويّات وكلّ الحدود. تبدّلت صورة الذات والآخر، وانمحت الحدود بينهما، حتى في البلد الواحد، فضلاً عن تلاشي العوائق باطّراد أمام انتقال الناس والأموال والثقافات، وهو ما يجعل التحدّيات بقدر الفُرص المُتاحة.
يُمكن اعتبار الكتاب الجديد للكاتب والصحافي محمد السمّاك: “الوثائق الإسلامية والعلاقة مع الآخر” خلاصة مكثّفة لتجربة طويلة وغنيّة خاضها المؤلّف في مجال حوار الأديان
نصوص قديمة لأوضاع جديدة
هل يعني التطوّر المتسارع عجز الإسلام عن التعامل معه أو الاستجابة لتحدّياته؟ وهل بالإمكان تنزيل نصوص سياسية قديمة في سياقات تاريخية مختلفة على واقعنا المعاصر، مثل “صحيفة المدينة”، أو العهد الذي جمع فيه الرسول صلّى الله عليه وسلّم بين المهاجرين والأنصار، وبينهم وبين يهود يثرب، بوصفهم كلّهم أمّة واحدة؟ ما زالت دولة “المدينة” أو polis اليونانية، ونُظمها السياسية، تُلهم الديمقراطية المعاصرة. وما زالت كتب أفلاطون وأرسطو في السياسة مدار فحص وتأمّل حتى أيّامنا. وكما كانت لأوروبا “مدينة” يونانية نموذجية، قبل آلاف السنين، فإنّ الإسلام انطلق أيضاً من مدينة، ليبني حضارة عالمية. وهذه المدينة، واسمها الأصلي يثرب، لم تكن على خطّ التجارة العالمية، كما كانت مكّة، لكنّها ستصبح تجربة فريدة لصناعة التاريخ.
في هذه المدينة، نشأ أوّل دستور، هو “الصحيفة”، يجمع مواطنين مختلفين على بنود محدّدة، ككتلة واحدة، وأمّة واحدة. وما تزال هذه الصحيفة ذات معانٍ لا تنضب، دون بقيّة المعاهدات التي عقدها الرسول مع نصارى نجران، أو الرسالة التي بعثها إلى دير سانت كاترين في سيناء، أو ما عهد به الخليفة الثاني عمر بن الخطاب لبطريرك القدس، عقب فتح فلسطين، وهو ما سُمّي بالعهدة العمرية، إذ يمكن وصف المعاهدات الأخرى بأنّها نوع من الالتزام بحماية حقوق الآخر. أمّا اعتبار مسلمي يثرب ويهودها أمّة واحدة، في سياق حلف دفاعي صريح ضدّ قريش وغيرها من القبائل المتحالفة معها، فذلك ممّا يستحقّ الدرس والفحص، علماً أنّ غدر اليهود لاحقاً بالرسول وبالمسلمين، أضاع مغزى الصحيفة وغرضها، وجعلها حدثاً منعزلاً وهامشياً في التاريخ الإسلامي كما في الفقه والاجتهاد. ولو صحّ التساؤل، فكيف كان اتّجاه التاريخ ليكون لو صدَق اليهود في التزامهم؟ وكيف يمكن تنزيل هذا النموذج على واقع اليوم؟ على الرغم من الدراسات الحديثة ذوات العدد في “صحيفة المدينة” وما تعنيه، سواء ما قام به باحثون عرب ومسلمون أو مستشرقون مستعربون، فما زالت الصورة ناقصة، ولا بدّ أن يكون للبحث صلة وتتمّة من خلال دراسات سياسية إسلامية معمّقة تتناول العلاقة مع الآخر من ضمن منهج مقاصد الشريعة، والتفاضل بين المصالح والأولويّات، وهو ما برع فيه الفقهاء القدامى.
المسلمون الأوائل منذ استقرارهم في يثرب وعلى مدى القرون اللاحقة، لم يؤسّسوا دولة يحكمها رجال دين
دولة دينيّة أم دولة مدنيّة؟
المسلمون الأوائل منذ استقرارهم في يثرب وعلى مدى القرون اللاحقة، لم يؤسّسوا دولة يحكمها رجال دين. أوّلاً، لم يكن للدين طبقة مغلقة من الرجال الذين يحتكرون الاجتهاد فيه، بل حثّ الإسلام كلّ المؤمنين على التفقّه في الدين. ثانياً، ظلّ الفقهاء المجتهدون على مختلف العصور، بمنأى عن تأثير السلطة السياسية، بل كان عدد من الخلفاء والسلاطين هم أنفسهم فقهاء، بمعنى أنّهم تعلّموا الأحكام الدينية كما يتعلّمها أيّ فقيه. ومن دولة “المدينة”، في أوّل الإسلام، إلى الدولة العثمانية وإلغاء الخلافة عام 1924، كانت أحكام الشريعة هي السائدة. وهذا لم يمنع من الإفادة من ثمرات الحضارات الأخرى، في كلّ وقت، في مجال النُظُم الإدارية اللازمة لتسيير الدولة، سواء من الإرث الفارسي أو البيزنطي. وفي زمن صعود الغرب، عقب الكشوفات الجغرافية أواخر القرن الخامس عشر واستعمار الآخرين في بلدانهم ونهب ثرواتهم، التي أنتجت تراكماً رأسمالياً هائلاً ساعد في إحداث الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر، بدأ ميزان القوى في العالم يختلّ، ودور الشرق الإسلامي ينحسر. وهذا ما تنبّه إليه الإصلاحيون العثمانيون في القرنين الأخيرين من عمر الدولة، سواء أكانوا سلاطين أو ولاةً أو دعاة، فبدأوا يتطلّعون إلى الاقتباس من الغرب، واستعمال أدواته ومنتجاته، لكنّهم فشلوا في عكس مسار الانحدار، ومردّ ذلك أسباب كثيرة ومعقّدة، ليس هنا مجال سردها كلّها أو جلّها، لكنّ أبرزها أنّ الإصلاحيين العثمانيين الأوائل، لا سيما السلطان محمود الثاني (توفّي عام 1839)، مالوا إلى التقليد الشكليّ للغرب، في العادات والأزياء، وركزّوا جهودهم على تحديث الجيش والقطاعات الرديفة له، ولم يتحوّل التحديث العسكري ليكون قطاعاً إنتاجياً يتوسّع تدريجياً ليصبح ثورة صناعية موازية. أمّا تجربة محمد علي في مصر (1805-1848)، التي توسّعت أكثر في مجالات تحديث مناهج التعليم، وإنشاء المدارس والمستشفيات، وإرسال البعثات العلمية المتتالية إلى أوروبا، فإنّ من أحبطها هو الغرب نفسه، الذي كان يتحيّن الفرصة المناسبة لوراثة الدولة العثمانية وتقاسم أراضيها، ولم يكن يريد طبعاً نجاح تجربة التحديث في مصر وقيام دولة مركزية قويّة في الشرق. فلا تكمن المشكلة في التخلّف أو التقليد وحسب، بل هو أكثر ما يكون في هيمنة الغرب على العالم، وقطع الطريق على أيّ قوّة منافسة، بكلّ طريقة ممكنة، وهو ما يحدث الآن بالنسبة لروسيا والصين.
إنّ مصطفى أتاتورك دمج بلاده تماماً بالغرب، قبل قرن، فبدّل أحرف اللغة التركية بالحروف اللاتينية وكانت عربية، واستورد ليس فقط المنتجات المادّية بل حتى القوانين والقيم والعادات الغربية، وفصل تركيا الحديثة تماماً عن الإسلام حتى في قانون الأسرة والأحوال الشخصية. وعلى خلاف غيره من الحكّام المتغرّبين، قام أتاتورك بتجربة تغريبية كاملة الأوصاف، لم يسبقه إليها حاكم في العالم الإسلامي. فلماذا كانت النتائج مختلفة عن التوقّعات؟ ولماذا ما زلنا نكرّر الكلام نفسه منذ قرنين؟ ولماذا لم نقُم حتى الآن بمراجعة علمية جادّة لكلّ محاولات التغريب العشوائي؟
توجد قاعدة إيمانية فقهية للدولة في الإسلام تقول بالعلاقة الوطنية على أساس احترام إيمان الآخر المختلف
الإسلام لا يقول بالدّولة الدينيّة
في هذا السياق، يُطرح السؤال نفسه عن ماهيّة الدولة الدينية. يجيب السمّاك في كتابه: “إنّ الإسلام لا يقول بالدولة الدينية، بمعنى الدولة التي يتولّى الحكم فيها رجال دين باسم الله أو بوكالة منه أو حتى بوكالة عنه”. وهذا صحيح تماماً، إذ لم تنشأ دولة في الإسلام بهذا المعنى. ثمّ يضيف أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم أنشأ دولة المدينة على قاعدة المجتمعين المختلفين اللذين يشكّلان أمّة واحدة، وهو لم يُلغِ الآخر المختلف دينياً، ولم يصهره. هذا صحيح أيضاً، لكنّ هذه التجربة لم تستمرّ طويلاً، وبسبب غدر اليهود أخرجهم الرسول من المدينة ومن جوارها ومن خيبر، ثمّ أخرجهم الخليفة عمر من كلّ الجزيرة العربية. فأين هو النموذج السياسي؟ وكيف يُراد تنزيله على الواقع المعاصر؟ وبأيّ طريقة؟ يقرّر السمّاك في هذه النقطة بالذات بأنّه “توجد قاعدة إيمانية فقهية للدولة في الإسلام تقول بالعلاقة الوطنية على أساس احترام إيمان الآخر المختلف. لكن لا توجد قاعدة دينية حكمية تفرض قيام العلاقة الوطنية على أساس دين الأكثرية أو على أساس دين الرئيس”. لكنّ صحيفة المدينة التي يعتبرها السمّاك نموذج الدولة المدنية تقرّر أنّه مهما اختلف المسلمون فيما بينهم، فإنّ مردّه إلى الله وإلى محمد. وتقرّر كذلك بعد ذكر قبائل يهود وعشائرهم، أنّه ما كان بين أهل هذه الصحيفة (مسلمين ويهوداً) من حدث أو اشتجار يُخاف فساده، فإنّ مردّه إلى الله وإلى رسول الله، أي إنّ النبي هو الحكَم بين الجميع، بنصّ الصحيفة. وكيف تكون العلاقة الوطنية بين المختلفين دينياً حتى لو كان المسلمون أكثرية؟ هل بالتنازل عن أحكام الشريعة، والاحتكام إلى قانون مدني حتى لا يكون الآخر مهمّشاً؟ هو مجرّد سؤال. أمّا التجربة التاريخية للدول في الإسلام، وصولاً إلى الدولة العثمانية قبل انقلاب العلمانيين على السلطان عبد الحميد الثاني، فهي حافلة باحترام الآخر المختلف دينياً، دون التخلّي عن الشريعة، بل بتطبيقها.
إقرأ أيضاً: في ذكرى المولد النّبويّ: النّبيّ في عيون “مفكّري” الغرب
لمتابعة الكاتب على X: