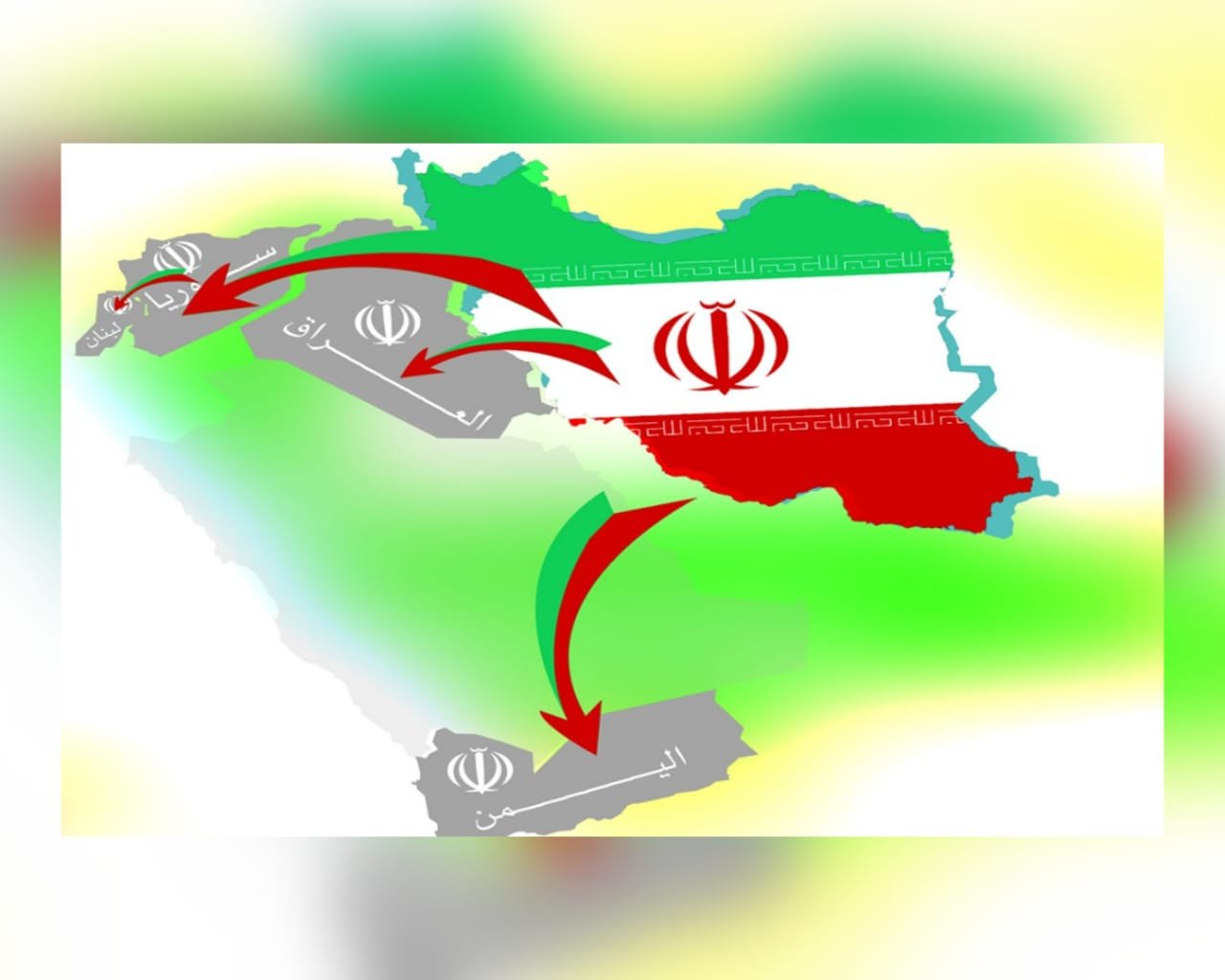تأخرتُ في الذهاب إلى مصر وهنّأت الشيخ أحمد الطيب بمشيخة الأزهر عبر الهاتف. إنما عندما زرتُه بعد انتفاضة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، قال لي: “هل تعرف يا مولانا (هكذا يخاطب كلّ الناس) البيت المصنوع والمنسوب إلى سيدنا نوح: تغيّرت البلاد ومن عليها؟”. وقلت: “ينبغي أن نتحدّث فأنتم منهمكون في عملٍ وطني وإسلامي جليل”. قال: “نعم، نلتقي مع صديقنا الدكتور محمد زقزوق (وكان قد استقال من وزارة الأوقاف) عند الخامسة هنا بالمكتب”. وعندما التقينا قلنا له أنا وزقزوق كأنما بصوتٍ واحد: “نتحدّث في الاحتساب؟”. فتبسّم غائب الذهن وأجاب: “نحن نقوم بعملٍ وطني احتسابي كبير بالفعل، وسأستشيركم في الأوراق التي نُعدُّها والتي يعرفها الدكتور زقزوق. لكنني مهتمٌّ ومهمومٌ بأمرٍ آخر أيضاً، وهو سؤال كبير: قرأتُ لك يا رضوان عنوان مقالٍ مخيف في مؤتمر بعُمان هو: إلى أين يتجه الإسلام؟”. وقلت: “العنوان ليس لي بل للمستشرق البريطاني المعروف المتوفى في السبعينات هاملتون غِب، وهو عنوان كتابٍ نشره في الخمسينات”. وتابع الطيب: “تقول يا مولانا إنّ الإسلام يعاني من انشقاقاتٍ كبرى عقدية وصحوية وجهادية، وأننا نعيش في زمنٍ عنيفٍ رأيت بداياته في الثورة الإيرانية وقي مقتل الرئيس السادات. وأنا أشاركك الرأي في إقبال مجموعات باسم الإسلام على العنف حتى هنا بمصر، لكن هناك فرق بين عنف القلة، والذهاب إلى حدوث انشقاق أو انشقاقات في الدين”. وقال له الدكتور زقزوق: “التكفير للدول والناس، واستحلال العنف، ألا تسميه انشقاقاً؟”. وقال الإمام الأكبر (هذا هو اللقب الرسمي لشيخ الأزهر): “لكن لا تنسوا السياسات الدولية والاستنزافات بين المسلمين، والتي حوَّلت المسالمين إلى أُناسٍ عنيفين”.!
إقرأ أيضاً: أحمد الطيب في مشيخة الأزهر (1/2): النمط المختلف في الزمن الصعب
مع اندلاع حركة “25 يناير”، ونزول الجمهور للشارع، وظهور أعمال عنفية ضد الأقباط والكنائس، وصعود التيارات الإسلامية في الشارع والانتخابات. أحسَّ الإمام ورجالات الأزهر الكبار بالأخطار والمسؤوليات.
مبدأ الأزهر، الذي صرَّح به الإمام مراراً، أنّه لا يتدخل في الشأن السياسي، وللأزهر خصوصية. لكنّه في النهاية مؤسسة كبرى من مؤسسات الدولة المصرية. إنّما في التحوّلات التاريخية، ينهض الأزهر بالشأن الوطني. تصوّروا أن الإمام المحافظ خاف على الطابع المدني والسلمي العميق للأمة المصرية، وللدولة المصرية! فقام بمبادرتين أساسيتين: صاغ مع الطوائف المسيحية وبخاصةٍ بابا الأقباط “بيت العائلة المصرية” للتضامن والتأمين وإحقاق العيش المشترك، ومنع العنف والتطاول من أيّ جهةٍ أتى. وقد قام البيت بجهودٍ جبارةٍ في اجتماعاته المتوالية إلى أن استعادت الدولة المصرية قوامها وقامتها مع زوال الاضطراب الذي أحدثه وصول الإخوان إلى “السلطة”. أما المبادرة الثانية الكبيرة للأزهر وشيخه فتمثّلت بتلك الأوراق والإعلانات بين 2011 و2013، التي جمع عليها الشيخ علماء الأزهر ورجالات الطوائف المسيحية، وكبار المثقفين المدنيين المصريين من كلّ حدبٍ وصوب. ما ترك الشيخ أحداً إلاّ ودعاه حتى أولئك الذين عُرفوا بالخصومة للأزهر، لأنّ الأمر يتعلّق بحاضر مصر ومستقبلها والذي تتضاءل أمامه كلّ الاعتبارات الأُخرى.
لقد صاغت هذه النخبة من كبار المصريين في زمن الثورة وتحت راية الأزهر، خارطةً للمستقبل الذي يُجمع عليه المصريون: “وثيقة مستقبل مصر” (14 حزيران، 2011) والتي تقول بالدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة. و”وثيقة الربيع العربي” (11 تشرين الأول، 2011)، والتي تعتبر أن شرعية السلطة الحاكمة من الوجهة الدينية والدستورية تقوم على رضا الشعوب واختيارها الحرّ. ومن حق الناس المعارضة والاحتجاج السلمي إذا أخلّ النظام السياسي بأمانة الحكم، وشراكة المؤسسات. وفي هذه الحالة ليس من حق السلطات استخدام القوة ضد المعارضين في الشارع، وإذا فعلت سقطت شرعيتها وجاز للمواطنين الثورة عليها، وبدون استخدام العنف أيضاً. و”وثيقة الحريات الأساسية” (8 كانون الثاني، 2010) وهي: حرية العقيدة، والحريات السياسية، وحرية الرأي والتعبير، وحرية البحث العلمي، وحرية الإبداع الفني والأدبي. و”وثيقة الأزهر الشريف لنبذ العنف” (31 كانون الثاني، 2013). وتقوم على حق الحياة وحرمة الدماء والممتلكات الخاصة والعامة، والتفرقة بين العمل السياسي والآخر التخريبي، وواجبات الدولة في حماية أمن المواطنين، والالتزام بالوسائل السلمية في العمل الوطني العام، وحماية النسيج الوطني الواحد، وحماية كيان الدولة المصرية. أما الوثيقة الخامسة والخاصة بحقوق المرأة فلم يقع إجماعٌ عليها، ولذا لم تصدر رغم التوافق على معالمها الرئيسية.
لقد كان العام 2013 قاسياً على الأزهر، حيث برز الإخوان والسلفيون وسيطروا في البرلمان والرئاسة والحكومة. ومع انتشار العنف والاضطراب في كلّ مكان، أدخلته السلطة الجديدة إلى الأزهر أيضاً فأُحرقت أربع يات، وتصاعدت التظاهرات من جانب الطلاب الحزبيين والتي تطالب تارةً بعزل رئيس جامعة الأزهر، وطوراً بعزل شيخ الأزهر. أما الأسباب فتتنوّع بين يومٍ وآخر. ولذلك عندما أزمع الجيش التدخل بعد أن تظاهر الملايين ضد نظام الإخوان، فإنّ شيخ الأزهر، وشأنه في ذلك شأن بابا الكنيسة القبطية، وجهات اجتماعية أخرى، وقفوا جميعاً مع الجيش بسبب المخاوف على الاستقرار والوحدة الوطنية، وموقع مصر العربي والدولي. وقد كتبتُ وقتها إن الأمر تراوح في مصر وخلال ثلاث سنوات من الاضطراب بين الخوف من الدولة، والخوف عليها (أزمنة التغير، 2014، ص 293).
ما إن خرج الأزهر مع مصر من كابوس الخوف على الدولة، حتى اندلع في وجهنا جميعاً العنف الديني أو العنف باسم الدين. قال لي شيخ الأزهر عام 2015، وكنا بصدد الإعداد لمؤتمر لمكافحة التطرّف والإرهاب: “ما هذه المصيبة؟ كلّ القرن العشرين كنّا خائفين على الدين، ويريد أولادنا الجهلة الآن، كما يريد الأجانب أن تصبح البشرية خائفةً من ديننا!”.
خلال فترةٍ قياسيةٍ قام شيخ الأزهر بالعمليتين اللتين تحدثتُ عنهما في عددٍ من أعمالي: “التأهّل والتأهيل”. قال لي الدكتور زقزوق رحمه الله: “لقد توقّعنا كلّ شيء إلاّ أن يقتل أبناؤنا أنفسهم وبني قومهم باسم الدين، ويقتلوا العالم. لقد تداولنا طويلاً في الأمر، وطرحنا معاذير الاستعمار والظلم عللاً لظهور التطرّف. لكنّ الصينيين والهنود عانوا أكثر منا فلم يُغيروا على برج التجارة العالمي وعلى السفارات والمطارات والقطارات والشواطئ ويقتلوا الناس استعراضاً”.
أقبل شيخ الأزهر على إقامة المؤتمرات والندوات ضد التطرّف وضد العنف والقتل، وفي مصر وغيرها. وبالتعاون مع دولة الإمارات أنشأ “مجلس الحكماء” الذي طوَّر فعالياتٍ لا تكاد تنتهي. وقد تبيّن للشيخ، أنّ الأمر لا يتعلّق بممارساتٍ عنيفةٍ من مجموعاتٍ مريضةٍ أو مخبولةٍ وحسب، بل هناك عملٌ دؤوبٌ على مدى عقودٍ لتحريف مفاهيم أساسية مثل الدين والشريعة والدولة والجهاد والسلم والحرب والقتال والناسخ والمنسوخ. ولذلك كان لا بدّ من القيام بأعمالٍ نقدية جذرية للتصحيح والاستقامة واستعادة الدين بالفعل ممن اختطفوه. وإلى جانب نقد ونقض ومكافحة ظواهر التطرّف والإرهاب، والتي أُنشئت لها مؤسساتٌ وقائية وتحويلية وتدريبية للأئمة، وأخرى إعلامية (“مرصد الأزهر” مثلاً)، وثالثة إفتائية سواء في الأزهر أو في دار الإفتاء؛ بدأ الشيخ التفكير بالبدائل. فعندما تنعى على الفتى التطرّف وتحريفات المفاهيم والعنف العشوائي والانتحاري، فإلى ماذا تدعوه؟ ما هو إسلام السلم والاعتدال الذي نذهب نحن إلى أنه هو الأصل؟ ويذهب الإصلاحيون إلى أنه الإسلام الجديد الملائم لحياة الإنسان والعمران. هذا هو النموذج الأصيل الذي انصرف الأزهر والمؤسسات الدينية السنية الأُخرى في السعودية والأردن والمغرب للعمل والتعاون على بنائه. وقد اقتضى ذلك تغييرات منهجية. إذ في البداية كان العلماء يهجمون على الإرهابيين بآيات السلم والودّ والبرّ والقسط، فيردُّ القتلةُ بآياتٍ يعتبرونها تدلّ على الحرب والجهاد. ولذلك صارت تظهر في نصوص وإعلانات وبيانات الأزهر ومنتدى تعزيز السلم ورابطة علماء المغرب، و”رابطة العالم الإسلامي”، النماذج والصُوَر التي تصنع رؤيةً جديدةً للدين في العالم، وذلك مثل حديث السفينة الدالّ على المسؤولية المشتركة، وكتاب المدينة أو عهدها الدالّ على التعدّدية الدينية والسياسية في الأمة والنظام السياسي، وحلف الفضول الجديد في الدعوة لإقامة نظامٍ عالميٍّ جديد على مكارم الأخلاق.
بعد زياراتٍ متبادلةٍ بين القطبين في الفاتيكان ومصر، اتفقا على وثيقةٍ سمياها “وثيقة الأخوّة الإنسانية”، وأصدراها في أبوظبي مطلع عام 2019 في احتفالٍ مهيب. وهي تفتح بالفعل عصراً دينياً جديداً طالما تمناه الإصلاحيون وتمناه سياسيونا ورجالاتنا الكبار
أما القطب الآخَر في اجتراح البدائل فهو التبصير والتوعية بأهمية الدولة والدولة الوطنية بالذات، لتطبيق مبدأ المواطنة، وحفظ الحقوق، واستتباب الأمن. الدولة هي العاصمُ من الطائفية والمذهبية والتطرّف وصناعة الميليشيات المسلّحة. وفي حين كان بعض العلماء يسعون إلى إعلانٍ وضماناتٍ للأقليات، ما قبل شيخ الأزهر بذلك مطلقاً، وقال إننا جميعاً مواطنون بدون أقلياتٍ ولا أكثريات، ونبني معاً دولنا الوطنية الدستورية. وفيما بين العامين 2015 و2018، جمع الأزهر في جنباته كلّ الطوائف والجماعات والإثنيات العربية المسلمة وغير المسلمة ليجدّد في الوعي والواقع مقولة الوحدة والتضامن الوطني، والأخوّة الدينية، وينصر الدولة الوطنية التي لا ينبغي إعفاؤها من مسؤولياتها بحجّة أولوية الدين أو الطائفة. فالدولة الوطنية هي ضمانة الدين أيضاً. أَوَلم يقل الماوردي إنّ الدولة بيدها حراسة الدين وسياسة الدنيا؟
بيد أنّ النجاح الأبرز الذي أحرزه الأزهر والإمام تمثَّل في المساحة المشتركة التي أقامها مع الديانات العالمية سواء الكاثوليكية أو الإنجليكانية أو الإنجيليات. وقد كان الأمر صعباً جداً في البدايات. فالعنف باسم الإسلام أبعد كلَّ البشر عن المسلمين. ومنذ العام 2006 ومحاضرة البابا بنديكتوس السادس عشر بجامعة “رغنسبورغ” عن عنف الإسلام ولا عقلانيته، قطع الأزهر علاقاته بالفاتيكان. علاقة عمل البابا فرنسِس والإمام على تجديدها منذ العام 2013. وقد قال لنا الشيخ في مناسباتٍ عدة إنه تأثر كثيراً بوقوف البابا الجديد مع المسلمين والإسلام منذ بداية بابويته. وفي العام 2016 وفي رسالته السنوية وكانت عن السلام، عَنْونَ لها البابا: “اسم الله هو الرحمة”، وهو يقصد الرحمن في القرآن. وفيها دعوةٌ للتضامُن مع اللاجئين والمهجرين، وحثٌ على رعاية حقوق الضيافة والجوار، وإنكارٌ على من يقول إنّ الإسلام دين إرهاب!
بعد زياراتٍ متبادلةٍ بين القطبين في الفاتيكان ومصر، اتفقا على وثيقةٍ سمياها “وثيقة الأخوّة الإنسانية”، وأصدراها في أبوظبي مطلع عام 2019 في احتفالٍ مهيب. وهي تفتح بالفعل عصراً دينياً جديداً طالما تمنّاه الإصلاحيون وتمنّاه سياسيونا ورجالاتنا الكبار. وهكذا، فإن المؤسسات الدينية العربية، وفي طليعتها الأزهر، تقود، للمرة الأولى منذ قرنٍ ونصف القرن، دعوةَ النهوض والعلاقات الحميمة بالأديان والثقافات والعالم. لقد صدرت وثائق وإعلانات كثيرة، لكني أريد التنبيه على وجه الخصوص إلى شقائق لوثيقة الأخوة الإنسانية: وثيقة مكة المكرمة (رابطة العالم الإسلامي)، وميثاق حلف الفضول الجديد (منتدى تعزيز السلم). فالروح واحد، والبنود متشابهة، وهذه الإعلانات دخولٌ في عالم العصر وعصر العالم.
لقد أردتُ في الذكرى العاشرة لتولّي صديقي الدكتور أحمد الطيب مشيخة الأزهر، أن أوجّه إلى شخصه ومسيرته هذه التحية السردية للقضايا والإنجازات، جزاء ما قدّم لصون الدين، واستعادة السكينة، وتجديد تجربة الدولة الوطنية، وصنع السلام مع عوالم الديانات والثقافات. إنه عملٌ احتسابيٌ كبير لمصر وللأزهر وللإسلام: {الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظُلمٍ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون}.
كانت تلك السيرة الموجزة للإمام الأكبر عملاً على النمط المختلف في الزمن الصعب، أو على النمط الصعب في الزمن المختلف.