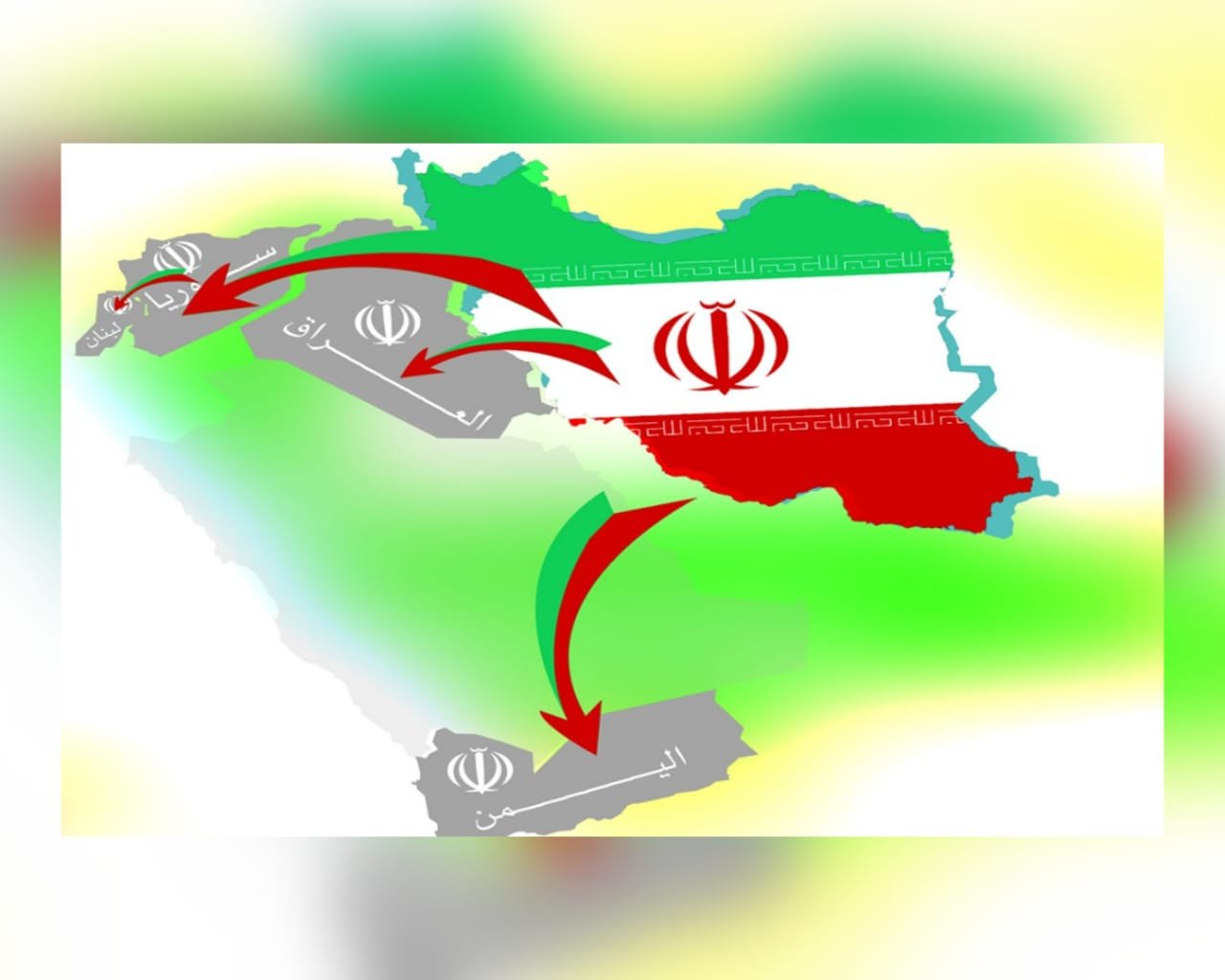يرسل الإنسان الرسالة إلى من يحب ومن يفتقد. ويرسلها إلى من يلتمس أو يأمل منه المشاركة في الهمّ أو المهمة. ويرسلها أخيراً إلى الذكرى الحافرة في الذاكرة التي صارت جرحاً مؤلماً. والرسائل إلى رفيق الحريري الإنسان والرئيس تجتمع فيها هذه الأسباب كلها. وقد اعتاد العرب في مثل ظروفنا على ترداد قول الشاعر: وفي الليلة الظلماء يُفتقدُ البدر.
نعم، نحن نفتقدك كثيراً وكثيراً جداً. نفتقد الإنسان الحاني، والكبير الراعي، وصانع الأمل لكل الناس. ونفتقدك نحن اللبنانيين على وجه الخصوص، لأنك أشرقتَ علينا في زمانٍ تكاثفت فيه الظلمات، فاستطعتَ بقلبك وعقلك، واقتناعك وإقناعك أن تصنع الفرق بين الظلمة والنور، وبين اليأس والأمل، وبين التفجع والرجاء. أذكر أنه قيل مرةً أمامك في مطالع التسعينات من القرن الماضي: “وصلنا إلى راحة اليأس”. فانصدمت وقمتَ من مقعدك، فقلتُ على سبيل التهدئة: “لكنّ القرآن يقول: إنه لا ييأس من رَوح الله إلا القوم الكافرون”. فالتفت الحريري إلى المستسلم لليأس وقال: “المشكلة أنه ليس في اليأس راحة من أي نوع. اليأس مرضٌ لا يُخرجُ منه إلا قطْعه، واليأس انتحار ينزل بالأفراد في ساعات التخلّي، لكنه لا ينزل بالأوطان والدول، تعالوا ننصرف إلى التفكير بالمخارج: لماذا يُنشئُ البشر دولاً؟”. وما انتظر الجواب، بل أجاب نفسه مُجيلاً الطرف بين الجالسين: “يفعلون ذلك لإحساسهم بوجودهم الإنساني والوطني، ولتحسين شروط حياتهم، وقد أقام أسلافنا هذه الدولة وما يزال اللبنانيون مجتمعين عليها، إنما المطلوب الآن تحقيق الهدف الثاني: تحسين شروط العيش، ليحسَّ الناس من جديد بفائدة الدولة لهم، فيستعيدوا الثقة بها ويحرصواعليها، ويدافعوا عنها”.
هكذا فهم كثيرون منا حياة رفيق الحريري السياسية، حتى من قبل أن يدخل إلى العمل السياسي. منذ مطلع الثمانينات عمل الحريري بالوطنية وبالوعي على إحياء فكرة الدولة والسلم الأهلي في أخلاد الجميع، وعلى إبراز “فوائدها”، نعم فوائدها للمواطنين أفراداً وجماعات. بادر بنفسه وإمكانياته إلى تنظيف بيروت من جوائح العدوان، وإلى إنشاء مؤسسة الحريري لتعليم الجميع، وإلى دعم الجامعات، وإلى دعم الجيش. ومنذ عرفته أواخر الثمانينات كان يردّد أنّه فيما يرى لنفسه يريد أن يكونَ رئيساً لبلدية بيروت لإحياء العاصمة عمراناً وتواصُلاً، وإذا أمكن ذلك – إلى جانب مساعي المخرج السياسي – فإنّ الدولة تستعيد عافيتها. وسمعتُهُ بعد الطائف يقول: “شوفوا كيف اتفق اللبنانيون بسرعة عندما وُجد الحَكَم النزيه. اللبنانيون يختلفون على الماضي، لكنهم يتفقون على المستقبل. لقد انفتحت أمامنا فرصة صُنع مستقبلنا معاً، وينبغي أن لا نقصّر أو نتردّد”.
نعم، نحن نفتقدك كثيراً وكثيراً جداً. نفتقد الإنسان الحاني، والكبير الراعي، وصانع الأمل لكل الناس. ونفتقدك نحن اللبنانيين على وجه الخصوص، لأنك أشرقتَ علينا في زمانٍ تكاثفت فيه الظلمات، فاستطعتَ بقلبك وعقلك، واقتناعك وإقناعك أن تصنع الفرق بين الظلمة والنور
كنّا نكتب له مرةً خطاباً عاماً (عام 1995 فيما أظن)، وكانت وقتها قد بدأت فترات اعتكافه أو استنكافه، وفي تلك الحالات كان كلامه يقلّ ويبدو غائب الذهن عن متابعة الحديث ويترك الآخرين يتحدثون. المهم أنّه عندما تسلّم الخطاب نظر فيه بسرعة، وبرقت عيناه وعادت إليه حيويته. كنّا في الخطاب (نهاد المشنوق وأنا) نكرّر فكرته عن “إجماع” اللبنانيين على المستقبل. قال متوجّهاً إليّ وإلى الحاضرين: “أنا أُفضّل كلمة الاتفاق على كلمة الإجماع لأنّ الناس عندنا ليسوا جماعات فقط، بل هم أفراد أيضاً، وإزاء الإجماع يحسُّون بقلّة الحيلة، وفقد الإرادة”. وقلت له قاصداً إظهار ثقافتي العامة: هل تعرف يا دولة الرئيس أنّ السياسي الفرنسي ألكسيس دي توكفيل كتب في أربعينات القرن التاسع عشر عن “الديمقراطية في أميركا” أنّها ثقافة الإجماع؟! فقال ضاحكاً: “أنا اشتبهتُ بثقافتك الدينية، لكنّه أمرٌ مهمٌّ ما قاله الفرنسي عن الأميركيين، إنّما يبقى طموحي وينبغي أن يكون طموحكم السعي الدائم للإقناع والاقتناع”.
لقد أردتُ من وراء هذا الاستطراد الطويل، الإشارة إلى معلمٍ آخر من معالم شخصية رفيق الحريري، وأسلوبه المفضل في الحياة السياسية. لقد كان مغرماً بإقناع المختلفين معه في أي شأن بوجهة نظره في نقاشٍ حرٍ ومفتوح. وكان يقول: “الذين يختلفون معك يختلفون لأحد ثلاثة أسباب: إمّا لأنهم يعتقدون أنّ هذه السياسة أو تلك تضر بمصالحهم الخاصة، أو لأنها تضرُّ بالمصالح العامة، أو لأنهم أُمروا بالاختلاف والمعارضة. المأمورون لا فائدة من مناقشتهم إنما لا بد من مجاملتهم وعدم معاداتهم. أما الفريقان الآخران فإقناعهم ممكن. بل إنّ المهتمين بالمصلحة العامة يمكن أن يقنعوك هم بوجهة نظرهم، ثقافة النقاش والإقناع ضرورية، وبخاصةٍ أننا خارجون من حربٍ ضَروس، وستكون هذه آخِر الحروب، لأننا نعمَّر البلاد، ولن يسير اللبنانيون وراء أي فريقٍ يريد العودة للهدم بعد كلّ ما عانوه”.
بعد ستة عشر عاماً على اغتيالك يا دولة الرئيس، نعرف يقيناً أن المأمورين هم الذين قتلوك في وضح النهار. لكنه رحمه الله كان مخطئاً في اعتقاده أن أحداً من اللبنانيين لن يسعى للعودة إلى الخراب، وإن سعى فلن يُمكَّنَ من ذلك. فنحن نعرف من سنوات أنّ سُعاة الخراب يمكن أن تكون لهم شعبية وشعبية كبيرة، وأن يُطْمعهم ذلك فيسعوا لخرابٍ فوق خراب، ولا لشيء إلاّ ليثبتوا لآمريهم أنّهم أكفاء في أداء المهمة. عندما سألوا قاتل المهاتما غاندي: “:كيف تحملتَ ارتكاب هذه الجريمة المستحيلة؟”. رفض الإجابة. لكنّ محاميه قال: “لقد اعتقد أن “ثقافة اللاعنف” الغاندية ستؤدي إلى انقسام البلاد، كان ينبغي مواجهة الانفصاليين بالقوّة. لكنّ الهند انقسمت بعد أقلّ من عامٍ على الجريمة، وقد كلفت نزاعات وتهجيرات الانقسام الملايين من الضحايا من الطرفين، وستظلّ تكلّف الدولتين الهنديتين الكثير الكثير”.
رسالتنا إليك في يوم استشهادك يا دولة الرئيس ليست رسالة شكوى بسبب تفاقم الأزمات على الوطن الذي عمّرته بالإقناع والاقتناع وحسْب، بل هي أيضاً رسالةٌ إلى اللبنانيين الذين عاقبهم القتلة جميعاً باغتيالك. ما قتلوا رؤية الإعمار والسلامة الوطنية، والعلاقة بالعرب والعالم فقط؛ بل قتلوا أيضاً آمالَ اللبنانيين في دولةٍ تحميهم وتحفظ سلمهم الأهلي، وتعمل على تحسين شروط حياتهم. بعدك، صار حاميها حراميها. بعد تعزية الأحنف بن قيس زعيم تميم للحسن بن علي في استشهاد الإمام، مرَّ بساحة واقعة صفّين فدلُّوه على عمار بن ياسر الذي قُتل في الوقعة، فوقف على القبر وخاطبه: “يا عمّار عندما رأيتَ جَزَعي وجزع الحَسَن بن علي على مقتل عثمان قلتَ لنا: لا عليكما، لن يتنطّح فيه عنزان. يا ابن أخي لقد هلك القطيع كله، وقُتل الجمل الأحمر”.
إنّ من يتأمل المشهد اللبناني طوال عقدٍ ونصف، يوقن بلا مبالغة أنّ كلَّ ما حصل ويحصل تداعيات لحدث العام 2005. ففي القرآن الكريم: {من قتل نفساً بغير نفسٍ أو فسادٍ في الأرض فكأنّما قتل الناس جميعا}. الذي يقتل مرّة عامداً متعمداً يقتل آلاف المرات. وتهلك الأوطان عندما تصبح حياتها السياسية والعامة سلسلةً من جرائم القتل بقصد السيطرة والإخافة وانتزاع السلطة. وهو الأمر الذي حدث ويحدث في لبنان: لقد سكت اللبنانيون فجاعوا، ورفعوا الصوتَ، فقُتلوا، وبين هذا وذاك اليأس الذي لا راحة فيه ولا عزاء.
لقد أردتُ من وراء هذا الاستطراد الطويل، الإشارة إلى معلمٍ آخر من معالم شخصية رفيق الحريري، وأسلوبه المفضل في الحياة السياسية. لقد كان مغرماً بإقناع المختلفين معه في أي شأن بوجهة نظره في نقاشٍ حرٍ ومفتوح
ماذا تفيدنا رسالتنا إليك، وأنت لا تستطيع التدخل للإنارة والتصحيح؟
الرسالة مفيدةٌ جداً، لأنها تذكيرٌ بالحريرية الوطنية الواسعة والمسؤولة والبانية. بل والحريرية السياسية السلمية والإعمارية والباحثة كل الوقت عن عملٍ يُعزّز ثقة الناس بدولتهم ووطنهم وإيمانهم بهما. لقد صارت الحريرية الوطنية نهجاً للسياسات الرشيدة والعاقلة والمستنيرة والباحثة بالعمل الجادّ عن الاتفاق، إن لم يكن الإجماع. ما منٍ أمرٍ صغيرٍ أو كبيرٍ يحصل وقد غبتَ منذ عقدٍ ونصف إلاّ ويسأل كلٌّ منّا نفسه ومحاوريه: “ماذا كان رفيق الحريري ليفعل في هذه الحالة أو تلك؟”. وإذا قيل إنّ في ذلك عجزاً وجموداً وسط متغيرات الأحوال، يصبح الجواب صعباً بالطبع. لكنّ السياسيَّ ورجل الدولة يظلُّ عزيز الوجود. وقد كنتَ كذلك وأكثر. كنتَ قبل كل هذا وبعده إنساناً بأعمق ما يكون عليه الإنسان. فإذا عزَّ علينا التشبه بإنسانيتك النادرة المثال فعلاً. فإنّ اسلوبك في التفكير الوطني والعمل السياسي يظلُّ حقيقياً بالاقتداء ولا تؤثر في صلاحيته متغيرات الظروف.
ولو تأملنا مسارات العمل السياسي والإعلامي لدى الآخرين على مدى ثلاثة عقود، لوجدنا أنّ همهم الأوحد كان وما يزال – لأنهم ما استطاعوا التخلص منك حتّى بالقتل – نسبةُ ما ارتكبوه إليك، والزعم أنّ ما أصاب البلاد في ماليتها وسياساتها إنما كان من صنعك. لقد تجاوزوا في ذلك كلَّ حد إلى درجة المهاترة، وادعاء الغريب والمستحيل. كلما ارتكبوا كبيرة بحقّ الوطن والمواطنين، نسبوها إليك. أيامك والدولة مفلسةٌ بعد الحرب، والتخريب الإسرائيلي مستمرّ، كان اللبناني لا يخاف وعنده هذا البحر الشاسع الذي تجتمع عند شواطئه وسواحله الثقة بالحاضر والمستقبل. لقد عاد اللبنانيون أيامك للانسياح في العالم وأنت على رأسهم بعلاقاتك وعملك على استعادة ثقة العالم. فليقولوا لنا ماذا فعلوا لمالية لبنان، وماذا فعلوا لقطاعه المصرفي، وماذا فعلوا للعلاقات بالعالم؟ وأولاً وقبل كل شيء وإذا لم تعجبهم سيرتك، فأين هي المالية التي نهبوها، والمصارف التي أفلسوها، والمستشفيات التي تسببوا بإغلاقها، والجامعات التي دمَّروا التعليم فيها، وأين هي الكهرباء التي كانت عام 1996 تأتي 24 على 24؟!
نعم، الرسالة إليك ومخاطبتك من أهدافها بعث الطموح، بالاندفاع إلى نهج الحريرية الوطنية التي لم تنتهِ ولن تنتهي لأنّه لا أمل للبنانيين ولبنان غير رؤيتها ومسارها من أجل متابعة إنجازاتها الإنقاذية لأنك بنيت وطناً وصنعت دولة في زمنٍ قياسي. كنت عام 1994 أو 1995 في وفد الرئيس الحريري إلى دُبي، فقال الحريري للشيخ محمد بن راشد: “أتينا إليكم لنتعلم من نجاح تجربتكم”. فتظاهر الشيخ بالاستغراب وقال: “بل نحن الذي تعلمنا ونتعلم من تجربة لبنان التي تجدّدت بحضوركم وعملكم، حفظكم الله للبنان ولنا يا شيخ رفيق”.
الرسالة مفيدةٌ جداً، لأنها تذكيرٌ بالحريرية الوطنية الواسعة والمسؤولة والبانية. بل والحريرية السياسية السلمية والإعمارية والباحثة كل الوقت عن عملٍ يُعزّز ثقة الناس بدولتهم ووطنهم وإيمانهم بهما
ولأختم بأمرٍ ترددتُ في ذكره، لكنه واجبٌ ومهمةٌ في ظروف الخراب وزمانه. الحريري هو ثالث رؤساء الوزارة الذين تعرضوا للاغتيال وفضلاً عن رابع اغتيل لكنّه لم يمت. ودائماً كان القتلة معروفين. ودائماً كانت الأسباب وطنية عامة، وليست شخصيةً أو حتى سياسية. كان المقصود على الدوام إفساد العيش المشترك، وتغيير النظام، وهوية لبنان وانتمائه، وتقصّد استتباعه للمحاور. ولو خامر رؤساء الحكومات وخامر المفتي خالد على أحد هذه الأمور لما استُشهد من استُشهد ولا ذهب إلى المنفى من ذهب. وفي هذه الظروف ونحن نتذكر الرئيس رفيق الحريري، يكون علينا نحن بالذات، المسلمين السُنة أن نصمد مع وثيقة الوفاق الوطني والدستور، ومع شرعيات لبنان الدستورية والعربية والدولية. الدور الذي يبحث عن مؤلّف أو مُخرج هو بأيدي أهل الطائف والدستور، وهو خياركم الذي يتوهم كثيرون أنهم يملكون غيره. لا يجوز أن تدفعنا الراديكاليات والمافيات باتجاه التطيّف أو التطرف أو الإحساس بالضعف أو التقوقع أو تقليد العنيفين والطائفيين والفاسدين والمتآمرين على لبنان: {من المؤمنين رجالٌ صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نخبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا}. نعم، لا بد من البقاء على التشبث بالدستور، وبالسياسات النبيلة للحريرية الوطنية، وبشعار صائب سلام: “لبنان واحد لا لبنانان”.
إقرأ أيضاً: 14 شباط 2005: الثابت والمتغيّر
أيّها الحريري الحبيب:
نحن اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى أكثر لوعةً وأكثر افتقاداً وأكثر حرصاً على الوفاء لسيرتك ومسيرتك، وأكثر إصراراً على الاقتداء بك في الصمود الوطني والعمل الوطني والوفاء للبنان الذي استودعته الله وشعبه: {إن يمسَسْكم قرحٌ فقد مسَّ القومَ قرحٌ مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين} (سورة آل عمران: 140).